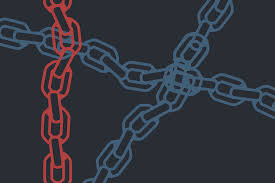مقالات مختارة تناولت ظاهرة “داعش” ودور “الإسلام السياسي” في الثورة السورية

———————————-
سوريا لمن؟ من خصخصة الدولة إلى خصخصة الثورة/ ياسين الحاج صالح
في شباط من هذا العام أصدر المجلس الإسلامي السوري في اسطنبول ما أسماها وثيقة الهوية السورية، دون أن يرفقها ببيان دواعي الإصدار، خلا إشارة مجملة إلى عشر سنوات من ثورة الشعب السوري على «النظام الطائفي المستبد»، مع استمرار هذا الأخير في محاولاته «طمس» هذه الهوية، معززة بـ«محاولات البعض التشويش والتدليس والتلبيس على معالم الهوية السورية». لا يوضح المجلس المكون من «علماء»، أي فقهاء / مفتين/ خطباء، وذكور، شيئاً عن هوية هذا البعض، لكن مقالة لمحمد أيمن الجمال تتناول الوثيقة بعين الرضا تشير إلى «العالم الغربي» مرة وإلى «الآخر» المحلي مرة، وإلى من «أعطوا جنسية البلد من الفرس الرافضة والأفغان» مرة ثالثة، ممن يحتمل أن يشكلوا معاً البعض «المُشوِّش المُدلِّس المُلبِّس» للهوية السورية.
هذه المناقشة تتخذ من وثيقة المجلس ومن مقالة الجمال موضوعاً لها، لكنهما كذلك مناسبة للنظر في تكون الوعي-الضمير الإسلامي السني المعاصر في سورية. ليس خوض معركة فكرية في هذا الشأن ترفاً ولا تنطعاً، إنه انشغال بمستقبل سورية والقضية السورية.
هوية سوريا
تقرر وثيقة المجلس الإسلامي السوري التي تبدأ بالبسملة ثم بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه البنود الخمس التالية تعريفاً للهوية السورية:
الإسلام هو دين غالبية الشعب السوري، وهو ثقافةٌ وحضارةٌ لجميع أبناء سورية.
سورية جزء لا يتجزأ من العالمين العربي والإسلامي.
اللغة العربية هي اللغة السائدة والرسمية في سورية.
الثقافة والقيم الحضارية المعهودة في التاريخ السوري الممتد لقرون معرّفات أساسية من معرّفات الهوية السورية، وكذلك الطابع العمراني والاجتماعي.
المكوّنات التاريخية العديدة الموجودة في سورية والمتنوّعة في ثقافاتها ولغاتها وأديانها وانتماءاتها هي مكوّنات أصيلة، وحقوقها مصونة مضمونة، وحريّات الجميع مكفولة متناغمة مع الهوية السورية الأصيلة، ولا تعود عليها بالنقض.
كما هو متوقع، الإسلام واحد بحسب واضعي الوثيقة، وهو الإسلام السني، على ما تدل اللغة المستخدمة، وعلى ما ينص صراحة محمد أمين الجمال في مقالته الشارحة التي سيجري تناولها أدناه. هذا يُخرَج من الإسلام الشيعة المنازعون للسنة على الشرعية الإسلامية، كما يُخرَج الجماعات التي تفرعت عن الجذع الإسلامي دون أن تكون منازعة على الشرعية الإسلامية، مثل العلويين والدروز والإسماعيليين. كان يمكن لذلك أن يكون مفهوماً بعض الشيء من قبل جماعة مشيخية تتكلم على شؤونها أو الشؤون العقدية لجماعتها، لكننا هنا حيال وثيقة تُعرف سوريا ككل، وتقرر أن الإسلام السني هو الإسلام. هذه من البداية وصفة تفجير، وليس استقرار وسلم.
من الناحية الديمغرافية الوصفية، ليس تقرير سنية أكثرية السوريين خطأ، لكن لسنا هنا حيال تقرير موضوعي مجرد لأكثرية عددية للسنيين السوريين. هذا بالأحرى تقرير معياري في وثيقة تصبو إلى أن تكون مرجعية، أو فوق دستورية، تصدرها هيئة يتواتر وصفها في الآونة الأخيرة بأنها «مرجعية»، ويبدو أنها تفكر بنفسها كذلك. تريد الوثيقة أن تكون مرجعية للسنيين السوريين الذي يحجب تعريفهم بالإسلام تعددهم المتعدد المستويات: الإثني (عرب، كرد، تركمان، شركس…) والاجتماعي (طبقات وشرائح، مدن وأرياف وبادية…) والجهوي والسياسي والفكري (علمانيون، يساريون، ليبراليون، متصوفة، إخوان، سلفيون، سلفيون جهاديون…). الأكثرية هنا تتحول من كونها علاقة سياسية متغيرة، تقوى وتضعف، في إطار اجتماعي سياسي متغير بدوره، لتصير جوهراً ثابتاً، لصيقاً بالمسلمين السنيين في كل حال. يجري هنا في وقت واحد نفي التعدد والاختلاف ضمن السنيين، ثم إضفاء وحدة سديمية على السوريين تحت عنوان عائم: الإسلام.
وليس إلا متوقعاً أن تنخفض عتبة تماهي السنيين بتصور سني للهوية السورية، فيما ترتفع عتبة غيرهم إلى حد أن تصير حاجزاً ومبعث غربة وإحباط. هل ثمة جدال في أن نحو ثلث السوريين من غير السنيين لن يتعرفوا على أنفسهم بهذه الهوية، وهذا مثلما لا يتعرف على أنفسهم غير العرب في التعريف البعثي لهوية عربية ثابتة للسوريين؟ ثم إن جميع السنيين سوسيولوجياً، لكن العلمانيين أو غير المؤمنين، يجري إعدامهم رمزياً بهذا التعريف الديني للهوية السورية، وهو ما يمهد للإعدام الفعلي إن أخذنا بالاعتبار سيرة المجموعات السلفية في سورية بعد الثورة.
المجلس لم يسأل أحداً من السوريين غير السنيين عما إذا كان الإسلام «ثقافة وحضارة» له. الواقع أن الإسلام ينزع إلى أن يكون ثقافة وحضارة لغير المسلمين في مجتمعاتنا حين يكون ثقافة وحضارة للمسلمين، أي حين يكون ثقافة وحضارة وليس سياسة أو مشروعاً سياسياً، ولا من باب أولى إيديولوجيا حرب. أعني بقدر يتناسب عكساً مع تسييسه، وأكثر مع تسييده. فإن جرى ذلك، وهو ما يجري منذ أربعين عاماً وأكثر، وجرى بشدة في العشرية المنقضية، فإنه يكف عن أن يكون أرضية إجماع للسنيين، دع عنك غير السنيين وغير المسلمين، وبالتالي لن يكون ثقافة وحضارة لأحد. وهذا لأنه لا يمكن أن يُزَجّ الدين في المنازعات السياسية والعسكرية، ثم يُتوقَّع أن يبقى عامل إجماع أو تقارب.
بعد الاحتواء السني لسورية تقرر الوثيقة أن سوريا جزء لا يتجزأ من العالمين العربي والإسلامي. لا جدال في ذلك وصفياً، لكن هنا أيضاً لسنا حيال تقرير وصفي محايد، وإلا لأمكن أن نضيف إليه مثلاً: والعالم. المشايخ يدركون كما ندرك سياسة الكلمات. يعلمون أن القول إن سوريا جزء لا يتجزأ من العالم يقتضي أننا مسؤولون عن العالم كما هو العالم مسؤول عنا، يعني العمل من أجل مبدأ للمسؤولية العالمية بوصف العالم فضاء لاختلاط أمم وثقافات وأجناس وأديان مكسباً للجميع، يعني كذلك أن نكون إيجابيين حيال العالم، وطن البشر والحياة، ونعمل على إصلاحه مع شركاء لنا في مختلف البلدان والثقافات. العالم «ثقافة وحضارة» لجميع البشر اليوم، بمن فيهم السوريون.
على أنه لا يبدو أن نسبة سوريا إلى العالمين العربي والإسلامي موجهة نحو استبعاد العالم حصراً، وإنما هي كذلك بمثابة توفير الإطار الأنسب لتعريف سوريا تعريفاً إسلامياً، أي هي بمثابة سور حماية لتعريف سوريا بالإسلام. «العالمان العربي والإسلامي» في واقعهما، أو في سياسة دولهما، أو في أفعال وأقوال مشايخهما، لا يسائلان ما يمتحن أقوال المشايخ السوريين أو يُظهر تعسُّفيّتها.
ومثل ذلك يصح على تقرير أن اللغة العربية هي السائدة والرسمية في سوريا. هنا سور إضافي، وفي داخله حظيرة تمر فيها بيسر أقوال وتقريرات المجلس الإسلامي السوري.
ليس واضحاً معنى قول الوثيقة إن «الثقافة والقيم الحضارية المعهودة في التاريخ السوري الممتد لقرون معرّفات أساسية من معرّفات الهوية السورية، وكذلك الطابع العمراني والاجتماعي». أخمن أن الأمر يتعلق بأعراف وعوائد اجتماعية موروثة أو «ممتدة لقرون». والحال أن هذه متغيرة في كل مكان من العالم. الثقافة ليست الطبيعة، والعوائد ليست طبائع، والأعراف ليست أوابد. وفوق كونها متغيرة تاريخياً، فهي متعددة في كل وقت، اليوم وفي الأمس وغداً. في ثقافتنا في ريف الرقة الشمالي، والسكان مسلمون سنيون في أكثرية ساحقة (كان هناك أسر أرمنية في تل أبيض)، لم يُعرف الحجاب الذي يغطي رؤوس النساء كلياً إلا حديثاً، فهل يجب حظر الحجاب لأنه طارئ، وليس من معهودنا الممتد لقرون؟ وفي منطقتنا نفسها كانت المساكن تبنى من الطين، وهي بيئية جداً وصحية، لكنها مستوجبة لصيانة سنوية. فهل هي من المعهود في التاريخ السوري، أم أن المعهود يشمل فقط ما يشبه أحياء الشام القديمة وحلب القديمة؟ أشير إلى زي النساء والمشهد العمراني في منطقة بعينها لأنه يبدو أن الإسلام الذي يزكيه المشايخ عموماً هو إسلام مديني، ذكوري، محافظ اجتماعياً، ومرتاح مادياً. إنه الإسلام الذي أنتجته وتثابر على إنتاجه سلطات دينية في كنف سلطات سياسية كانت استبدادية، وإلا فطغيانية، بدون استثناءات تذكر.
القصد أن «المعهود في التاريخ السوري» هو تقليد لا يكف مشايخ ذكور عن ابتداعه وتعميمه، وأن فكرة هوية سورية تقوم على الإسلام السني هي اختراع حديث جداً، ظهر في شروط تاريخية معلومة، أولها بطبيعة الحال هو ظهور شيء اسمه سوريا في التاريخ وفي العالم. وهو ما حدث في نهاية الحرب العالمية الأولى كدولة وطنية حديثة يفترض أن تقوم على المواطنة (دون أن يطابق واقعها ذلك حقاً). لظهور سوريا كدولة حديثة بوادر سابقة عليها، تعود إلى حقبة التنظيمات العثمانية منذ 1839، وقد جاءت إصلاحاتها استجابة لانحدار السلطنة ومسعى للتحديث. لذلك لا يستقيم كلام المشايخ إلا بافتراض استمرارية تاريخية متجانسة، هي استمرارية هوية متجانسة بدورها ولا تتغير، وهذا ليس واقع الحال. تاريخ سوريا خلال قرن ونيف هو انقطاع عما سبق، وهو شهد خلال قرن ونيف انقطاعين كبيرين لما يُحَط بأقدمهما كفاية، ومن باب أولى بثانيهما: الأول هو تحول سوريا إلى دولة سلطانية محدثة بعد ثلاثين سنة من حكم الطاغية حافظ الأسد، والثاني هو وقوع البلد تحت احتلالات متعددة يحتمل أن تستمر عقوداً (ظلت ألمانيا منقسمة لنحو 45 عاماً بفعل احتلالها إثر الحرب العالمية الثانية)، وقد تزول سوريا على نحو ما عرفناها بأثر حداثة وجودها في التاريخ وغزارة التدخلات الخارجية التي صارت احتلالات، و«التخرجات» الداخلية التي صارت تبعيات وطلبات لحماة مختلفين. أعني بالتخرجات الداخلية طلب قطاعات من الداخل السوري الارتباط بقوى خارجية بغرض تعزيز الوزن أو الحماية أو نيل أرجحية في التنافس مع مجموعات داخلية أخرى. لكن «التخرج» هذا يلغي الداخل على نحو يشكل مصير سوريا اليوم مثاله الناطق. الحكم الأسدي طليعي في التخرج والتبعية وطلب الحماية من الإيرانيين وأتباعهم، ثم من الروس. لكن الإسلامية السورية بمجملها اليوم تابعة لتركيا، والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم الاتحاد الديمقراطي الكردي محمية أميركية. وليس في وثيقة المشايخ إلا ما يندرج في ديناميكيات الاستقطاب والتقسيم و«التخرجات».
يمكن التفكير في البنود الثاني والثالث والرابع من الوثيقة كأسوار حامية. القلب المحمي هو إسلامية سوريا التي نص عليها البند الأول، ثم البند الخامس حول المكونات: «المكوّنات التاريخية العديدة الموجودة في سورية والمتنوّعة في ثقافاتها ولغاتها وأديانها وانتماءاتها هي مكوّنات أصيلة، وحقوقها مصونة مضمونة، وحريّات الجميع مكفولة متناغمة مع الهوية السورية الأصيلة، ولا تعود عليها بالنقض».
بعد أن قرر المشايخ سنية سوريا، يعرضون في البند الخامس من وثيقتهم كرماً حيال غير السنيين، لكن على طريقة طبطبة السيد على كتف التابع. يصون المشايخ حرية «المكونات»، والأرجح أن المقصود أنهم لن يُجبَروا على دخول الإسلام (السني)، وتُترَك لهم شؤونهم الدينية الخاصة وفق نظام أهل الذمة المعروف الذي ألغته التنظيمات العثمانية قبل ما يقترب من قرنين. لكن الوضع الذي قامت ضده الثورة السورية يؤمن «حريات المكونات» هذه وأكثر، بما فيها بالمناسب حرية «المكون السني». المشايخ لا يَعِدون المكوّنات بغير حريات لا يتجاوز سقفها ما هو متاح لها، المكونات، من حريات في ظل النظام، وربما أقل. الحرية التي حرم منها السوريون في الحقبة الأسدية والبعثية ليست حرية المكونات بحال، بل حريات الأفراد حيال الدولة (وضمنياً حيال المكونات). ولا يستقيم مفهوم الحرية كسيادة للأفراد على أنفسهم دون حرية الاعتقاد الديني، بما في ذلك حرية عدم الاعتقاد وحرية تغيير الاعتقاد، وحرية اللامبالاة بشؤون الاعتقاد، فضلاً عن الحريات العامة والسياسية. وفي أي سياقات إسلامية، لا بد أن يشمل تصور الحرية الحريات الاجتماعية الخاصة بالزي والأكل والشرب والاختلاط بين الجنسين، وهي حريات يخشى المرء عليها من الإسلاميين وليس من الأسديين وما شابه. وليس بين هذه القضايا ما يتنطع كاتب السطور بالكلام عليها، بل هي قضايا طرحها مسار السنوات العشرة المنقضية بصور بالغة القسوة، وصلت حد الخطف والتغييب، بل حد الصلب والرجم، والغافل وحده هو من يستطيع الاستمرار في التفكير في شأن سياسة الإسلاميين ومعتقداتهم دون إثارتها.
بالمناسبة، لماذا النظام استبدادي طائفي، إن كان المشايخ يفكرون في السوريين كـ«مكونات»، وينكرون حرياتهم كأفراد؟ الطائفية هي حصر الأفراد في منابت دينية ومذهبية موروثة سواءً بقوة القانون (أو «الشرع») أو عبر التمييز السياسي النشط بينهم، والاستبداد هو إنكار حرية الرأي والتعبير والاعتقاد والتجمع والتنظيم على الأفراد المختلفين. ما يعد به المشايخ، بالتالي، ليس أكثر من نظام استبدادي طائفي بسيادة سنية، يحل محل نظام استبدادي طائفي بسيادة علوية.
وليس واضحاً بعدُ من هي «المكونات» التي يعتبرها المشايخ أصيلة. هل العلويون مشمولون بها؟ والدروز؟ والاسماعيليون؟ والإيزيديون؟ أم هي مقتصرة على «أهل الكتاب»، أي عملياً على المسيحيين؟ هنا أيضاً المسألة طرحها الواقع، ولا يفتعلها الكاتب. جيش الإسلام وجبهة النصرة وداعش استهدفوا علويين بوصفهم علويين، واعتقلوا وقتلوا نساءاً ورجالاً وأطفالاً وشيوخاً. وداعش قتلت رجال الإيزيديين في سنجار وسبت نساءهم واستعبدتهن جنسياً وشرّعت ذلك دينياً (لم يُسمَع صوت للمشايخ ضد ذلك بحدود ما أعلم). السياق المعلوم لحدوث هذه الجرائم، أعني اندلاع المنازع الإبادية لدولة الأسديين بعد الثورة، لا ينزع عنها صفة الجرائم.
ثم ليس واضحاً كذلك المقصود بكفالة حريات «المكونات التاريخية»، «متناغمة مع الهوية السورية الأصلية»؟ هذا يشبه اشتراطاً من هذه الهوية الأصيلة المزعومة، أي السنية، على «المكونات التاريخية»، يوجب عليها أن تنضوي ضمن تلك الهوية، وألا تعود عليها بالنقض. هذه الصيغة الملتبسة باب لتدخلات سلطوية من كل نوع باسم الهوية الأصلية التي لا يجوز نقضها. هل بناء كنيسة جديدة يعود بالنقض وعدم التناغم على «الهوية الأصيلة»؟ أو امتلاك خمارة؟ أو ارتداء زي يقرر جهاز حسبة مشايخي أنه غير محتشم؟
في المحصلة، تصور الهوية الصادر عن مشايخ المجلس الإسلامي السوري ساكن وغير ديناميكي، يجعل من معطيات متشكلة تاريخياً ومتغيرة تاريخياً الأساس الثابت لهوية البلد، يغفل كلياً ما يتصل بعناصر الهوية الأحدث، رغم أن إطار الهوية المحال عليه، سوريا، حديث كلياً ولم يكن له وجود قبل نهاية الحرب العالمية الأولى.
عن السياق
نفهم الوثيقة التي لا تصرّح بشرطها السياسي إن فكرنا فيها كتعبير عن قلق وجودي يعرضه المشايخ السنيون بفعل تحطم بيئات سنية سورية واسعة، سواء بالمجازر أو التهجير، وبالتالي تطلع نافذين ضمن هذه البيئات إلى ضرب من الحماية. لا القلق الوجودي، ولا الحاجة إلى الحماية، اختراع مشايخي. النظام الطائفي الذي ميّز بين السوريين وأقام سياسته مثل الاستعمار الفرنسي على حماية الأقليات ولّد مطلب حماية الأكثرية الذي يصدر عنه المشايخ، دون أن يحظى أحد بالحماية في واقع الأمر غير الطغمة المالكة الحاكمة. وتأخذ حماية الأكثرية شكلاً محسوساً يمتزج فيه التهجير مع التشييع مع الإحلال، مما هي ركائز لمشروع توسعي إيراني في سوريا، إلى جانب العراق ولبنان، عمليات فاقمت بمجملها ما كانت دِبرا آموس سمته في كتاب لها سبق الثورات العربية «الأفول السني» (تُرجم إلى العربية بعنوان: أفول أهل السنة). وهذا اتجاه توطّد بعد مشاركة إيران مباشرة وعبر ميليشياتها اللبنانية والعراقية وغيرها في سحق الثورة السورية، وفي حماية النظام الطائفي (أُشارك المشايخ التشخيص، وإن بدلالة مغايرة، فصّلتُها في كتابي: السلطان الحديث، 2020). وثيقة المشايخ يبطنها قلق الأفول، لكنها لا تسمّي هواجسها بأسمائها، ولا تستطيع صوغ خطاب عدالة وإنصاف حولها، يخاطب عموم السوريين وعموم الناس. خيالها السياسي المسكون بأشباح إمبراطورية من الماضي الغابر يقودها نحو إعلان مناقض كلياً للواقع: سوريا سنية (وهذا بينما المتن السوري يقع في كنف دولتين قوميتين، لا تشكو منازعهما الإمبراطورية من الخفوت: إيران وروسيا). الجماعة لا يتكلمون بمنطق صاحب القضية العادلة الذي يخاطب العادلين في كل مكان مستنصراً وطالباً التضامن والشراكة، ولا بمنطق الضعيف الذي قد يطلب أماناً مساوياً لنفسه مع غيره، ما قد يدفع إلى ميثاق أمان عام سوري، بل يتكلمون بعتو وتعالٍ مألوف. هذا العتو أو الصلف السني يبدو أثراً لميراث إمبراطوري قديم، للاعتقاد بحق السيادة واللامساواة مع الغير في «الشرف» والسلطان، ولاستثناء دائم للنفس من قواعد تعمها مع غيرها. وما يثير السخرية هو أن هذا التكوين النفسي الأخلاقي يتعارض اليوم كلياً مع وضع المسلمين السنيين في سوريا وفي كل مكان. هناك حالة ضعف وفشل عامة، تقود إليها الدول في مجالنا، كما يقود إليها الدين بشهادة كل التجارب التي قامت باسمه في الأربعين سنة الماضية. وقد يجازف المرء بالتفكير في حاجة المسلمين السنيين إلى سياسة تتوافق مع شروطهم الواقعية، أي التصالح مع شرط الضعفاء الذي يعملون إلى جانب أشباههم من الضعفاء على تغيير الواقع، ومن أجل المساواة والحرية والاحترام. أعني أشباههم من المسلمين وغير المسلمين، من الغارمين في عالم اليوم، وممن يتطلعون إلى عالم أعدل يعيشون فيه بكرامة. كان من شأن ذلك في تصوري أن يجعل الإسلام دين احتجاج الضعفاء على الإمبريالية في نطاقات عالمية أوسع. لكن ليس هذا هو الإيثوس أو النَّفَس السائد في بيئات الإسلاميين السنيين. السائد هو عنجهية ديانة المنتصرين، رغم هزيمتهم الواقعية وضآلة شأنهم الواقعي. ويتظاهر هذا السائد في طلب السيادة، أي عملياً الحق الحصري في القتل والتعذيب والاستتابة (وليس السياسة حيث يكونون قوة بين قوى أو طرفاً بين أطراف)، وانتحال سلطة تعريف الكل، وعدم احترام أي كان أو الاعتراف بأي كان كندّ ومساوٍ. الإسلاميون «إمبرياليون مقهورون»، مع كونهم في الوقت نفسه من ضحايا الإمبرياليات القاهرة، الغربية والروسية والصينية، ولذلك يفتقر احتجاجهم على الإمبرياليات إلى محتوى تحرري. ماذا يُحتمَل أن تكون سياسة الضعيف الذي يحلم أحلاماً إمبراطورية بدل أن يحلم بالمساواة والأخوة؟ الإرهاب، الغدر بالأقوياء. الإرهاب ينبثق من هذه الفجوة الفاغرة بين ضعف لا يطاق وبين تطلع إمبراطوري لم يُصفَّ الحساب معه. أو هو الحل العنيف للتناقض بين واقع المهزومين وديانة المنتصرين، الحل الذي لا يحل مشكلة الضعف والهزيمة، بل يبعث على الانحلال والأفول. الأقوياء سيردون بـ«الحرب ضد الإرهاب»، وهذه تعذيب جماعي وليست حرباً بحال، ومن هذه الدورة تتولد العدمية والكراهية والاحتقار الشامل، ومجتمعاتنا وليس مجتمعات الأقوياء هي التي تدمر وتتدهور.
يتكلم المشايخ باسم مسلمين سنيين سوريين تعرضوا لتشتيت رهيب وتمزق مجتمعاتهم تمزقاً قد لا يُرأب، وخرجت من صفوفهم تشكيلات إجرامية شريرة فاقمت تمزقهم ودمار بيئاتهم، ومع ذلك ترى المشايخ، وهم أنفسهم لاجئون في تركيا، يتشرطون على غيرهم ويتكلمون كأنهم فاتحون.
لا يغفل كاتب هذه السطور، وهو نفسه لاجئ مثل المشايخ، عن طائفية النظام، ولا عما تعرضت له بيئات سنية من تمييز طوال الحقبة الأسدية، ومن تدمير تمييزي بعد الثورة، استهدفها وحدها بالمجازر الكيماوية والبراميل المتفجرة والقصف بالطائرات، واغتصاب نساء ورجال في مقرات أجهزة الأمن الأسدية، الطائفية بشدة. كل ذلك باعث على الغضب، لكن مقاربة المشايخ للهوية السورية تضفي صفة نسبية على جرائم النظام، ما دامت لا تقترح غير هوية سنية لسوريا، وبالتالي حكما سنياً، وليس وطنية سورية استيعابية تقوم على المواطنة.
لا يقف مبدأ حماية الأكثرية، الذي هو المحتوى الفعلي لوثيقة المشايخ، في مواجهة حماية الأقليات، التي جعل منها النظام حجر الزاوية في حملة علاقات عامة يديرها في الغرب والعالم. بالعكس، هو يزجنا في منطق حرب أهلية دائمة، ويحكم على مستقبلنا بأن يكون استمراراً سنياً للأسدية.
تطييف وتبعية
وثيقة الهوية السورية تعكس تقدم تطييف السنيين السوريين، وشمول طلب الحماية الجميع، الكثيرين وغير الكثيرين. الكل في قلق وجودي، خوف من الفناء. ومع قلقهم هذا، لا يُحتمَل للسنيين السوريين، بصفتهم هذه، أن يحظوا بحماية أي كان. سوريا تبدو أهم لإسرائيل ولروسيا ولأميركا من أن تُترك لحكم سني. سبق لوزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف أن قال ذلك علانية. وليس في ما تعرضه سياسة الإسلاميين، ومنهم مشايخ المجلس الإسلامي السوري في إسطنبول، من قلة احترام لأي كان في العالم، وقبل ذلك للسوريين غير السنيين وللسنيين غير النمطيين، ما يدفع أياً كان إلى مراجعة هذا التفكير. صحيح أن عالم اليوم ليس مرجعية عادلة يُستنَد إليها، لكن من سيساعد الضعيف المتعجرف الذي لا يساعد نفسه، ويظن أنه يحتكر الصواب في العالم؟ يمكن لتركيا أن تحمي المشايخ والإخوان والسلفيين التائبين، مثلما تحمي إيران وروسيا بشار ورهطه. لكن هذا يجعل المحميين عملاء والحماة سادة. أوهام المشايخ وتصوراتهم الذاتية لا وزن لها أمام وقائع القوة الفعلية.
ويرجِّح هذا السياق ألا تحظى مساعي بناء مرجعية سنية سورية بالحياة لأنها ولدت مصابة بتشوه ولادي: التبعية! وإنما لذلك ليس المجلس الإسلامي السوري مكاناً مناسباً للكلام على «القرار الوطني السوري المستقل»، مثلما تراءى للسيد جورج صبرا في كلمة له أمام المشايخ في صيف 2017. بعد حين تتغير المعادلات السياسية التي نشأ فيها هذا المجلس، ويجد القوم أنفسهم «على الحديدة»، مثلما يبدو أنه يحصل للإخوان المسلمين المصريين بأثر التقارب بين الحكومتين التركية والمصرية. ما يمكن أن ينقض ذلك ويحمي من الأفول هو عكس ما يقوم به المشايخ بالتمام: التواضع والتعلم وتغيير الذات والاحترام والشراكة مع الغير.
الإسلامية المطلقة
تصدر وثيقة مشايخ المجلس الإسلامي السوري عن تصور للذات يمكن تسميته الإسلامية المطلقة على غرار العروبة المطلقة، البعيثة. العروبة المطلقة تقرر أن السوريين كلهم عرب، وعروبتهم ماهوية، مثل إسلامية السوريين بحسب المجلس الإسلامي السوري؛ وأنهم جزء من «الوطن العربي الكبير» الذي ينفصل عن غيره بحدود طبيعية: صحاري وبحار، بينما لا تفصل بين أقطاره المختلفة غير حواجز مصطنعة من صنع الاستعمار. أي أننا كلنا مثل بعضنا، كلنا عرب، وكلنا على اختلاف تام مع غيرنا من غير العرب. من قد يمثلون شوائب أو خروجاً على هذا المنطلق، «يُجْلَون من الوطن العربي» على ما قرر دستور حزب البعث عام 1947. وبطبيعة الحال سيكون الحكم حقاً شرعياً ودائماً لرافعي راية العروبة. الهوية ثابتة لا تتغير، طبيعة. لكن هذا وهم، وليس هناك ما هو ثابت إلا الموت. الهوية الثابتة هي نتاج تثبيت يقوم به منتفعون، يجنون منها مكاسب رمزية وسياسية ومادية، ويعود عليهم تثبيتها بإشغال وضع مرجعي، يجنون منه الوجاهة والطيبات.
الإسلامية المطلقة تقرر أنه كلنا مسلمون، إن لم يكن اعتقاداً، فثقافة وحضارة بحسب المشايخ. ثم أنه كلنا مختلفون عن غيرنا من غرب وغيره اختلافاً تاماً. ومثلما أن العروبة المطلقة لا تعني بحال أن العرب كأفراد ومجموعات حظوا بامتيازات رفعتهم فوق غيرهم، فإن الإسلامية المطلقة لا تعني بحال أن عموم المسلمين، أو المسلمين السنيين، سيكونون بخير في ظل حكم إسلامي. داعش والنصرة وجيش الإسلام، وهم إسلاميون مطلقون، أسسوا إمارات طغيان وتعسف، عانى منها «عوام المسلمين» أكثر من غيرهم، وجعلوا الجريمة منهج حكم مثل الأسديين.
وثيقة المجلس الإسلامي السوري تنتمي إلى عالم الإسلامية المطلقة والفوق-دستورية، لا إلى إسلامية دستورية يمكن أن تقول إن المسلمين يعيشون في مجتمعات عينية مختلطين بغيرهم ومتمايزين داخلياً إلى جماعات فرعية مختلفة وأحياناً متنازعة، وأنهم جزء من بشرية تعاني من مشكلات كبيرة وعليهم أن يساهموا في حلها، وأن يكونوا سنداً لغيرهم في قضايا العدالة والتمييز مثلما يجدر بغيرهم أن يكونوا سنداً لهم، وأن الحكم السياسي يتوجه بهذه الاعتبارات التي تولي كرامة السكان المختلفين وإضعاف منابع التوتر المحتملة أعلى أولوياتها، وأن المسلمين يستلهمون ما في دينهم وتاريخهم من مبادئ تعين على السير في هذا الاتجاه. الإسلامية الدستورية هي وحدها «ثقافة وحضارة»، إن حاكينا لغة المشايخ، وهي من يمكن أن تكون ثقافة وحضارة لغير المسلمين في بلدان يشكل سوادها من مسلمين. الإسلامية المطلقة لا يمكن أن تكون ثقافة وحضارة لأحد، ولا للمسلمين السنيين. ومعلوم أن تشكيلاتها أخذت الإسلام لنفسها، وهي (وليس أي علمانيين) من فصلته عن المجتمع الذي حسب نفسه مسلماً على الدوام، وصارت تعيد أسلمة المحكومين بالدورات الشرعية وشرطة الحسبة، إلى درجة أن صار لسان الحال يقول: «يا أخي هدول الجماعة عندن دين نحن ما بنعرفو» (تُنظَر مقالة أوس مبارك عن جهاز الحسبة في جيش الإسلام). الإسلامية المطلقة نظام حزب واحد ديني، بالغ المحافظة، عنيف، ونزاع نحو الفاشية. هو بعثية إسلامية. الإسلامية المطلقة هي إسلامية التطبيق، سواء تطبيق الشريعة أم تطبيق العقيدة أو الحاكمية الإلهية. مفهوم التطبيق فاشي في كل حال، سواء تعلق الأمر بالتطبيق الاشتراكي أو تطبيق الشريعة، يعامل الحياة البشرية والاجتماع البشري كأشياء مِطواعة يمارس عليها المطبِّقون السياسيون والدينيون معتقداتهم المعصومة، فيحذفون بعنف لا يحد ما لا يتوافق مع ما يمليه اعتقادهم. ولقد رأينا النماذج سلفاً. قول ذلك هنا أيضاً ليس مسألة استدلال منطقي.
والسؤال الذي طرحته علينا نماذج الإسلامية المطلقة أو السلطات الدينية المطلقة هو كيف يمكن ضبط هذه السلطات؟ كيف يمكن منعها من الطغيان؟ من قيام نظام حِسْبوي تجسسي، يتلصص على سماع الموسيقا أو اختلاط نساء ورجال، أو لون طرف ثوب امرأة تحت نقابها الأسود، أو مقالات يتشمم منها مخبرون دينيون نفساً غير تبجيلي للعقيدة المفروضة؟ كيف يمكن دسترة هذه السلطة؟ كيف يمكن حماية المجتمع منها؟ أيا يكن الأمر، فإن الدستور الضابط لسلطة ما لا يمكن أن ينبع من هذه السلطة على نحو ما تريد الإسلامية المطلقة. ما يحمي المجتمع من سلطة الإسلاميين ليس شرع الإسلاميين، بل دستور مدني، وضعي، تصدره «جمعية تأسيسية» السوريين.
خصخصة الثورة سنياً
ليس غرض هذا التدخل بطبيعة الحال هو إقناع المشايخ بخلل تفكيرهم. الجماعة يعيشون في عالم يخصهم عالي الأسوار. الغرض هو مخاطبة غير المشايخ من السوريين ممن يعيشون خارج الأسوار لإظهار خطورة هذا الطرح الذي يستفيد تمام الاستفادة مما تورثه سلطة إبادية كالحكم الأسدي من انفعال وغضب كي يضعف المنازع النقدية حياله. كلام الرجال المتدينين المدينيين الملتحين المقيمين في إسطنبول طائفي وتمييزي، وليس لحكم طائفي، قاتل وعميل، أن يحجب حقيقته. هذا يظهر بوضوح أكبر في مقالة الدكتور محمد أمين الجمال الذي يدنو من الأرض و«أبناء هذه الأرض» كما سنراه يقول، ولا يحوم في سماوات العمومية التي حوّم فيها المشايخ.
في مقالته التي تعلق على وثيقة المجلس الإسلامي السوري وتشرحها وتدافع عنها، والتي نشرت مثلما تقدم في مجلة المجلس، مقاربات، يقرر الجمال بداية أن «شعوبنا التي خرجت من المساجد بشعارات عفويّة في أوّل الثورة تهتف للحريّة لهي أحقُّ بإعلاء قيمة الهويّة، وأولى أن تكون الهويّة متمثّلة في منطلقاتها في الحياة ومنطلقاتها في الثورة». ويضيف مؤكداً: «لم يخرج الثائرون ليعبّروا عن هويّة شيوعيّة ولا عروبيّة قوميّة، ولا كرديّة ولا شركسيّة، ولا ليعلنوا انتماءهم إلى الديمقراطيّة الغربيّة أو الليبراليّة الأوروبيّة، بل خرجوا تعبيراً عن هويّة دينيّة». هنا عدد كبير من المصادرات لا مفر من التوقف أمامها. خرج الثائرون بدءاً من درعا ضد نظام بهيمي، يعذب الأطفال ويهين الآباء، ويعامل عموم محكوميه بعنجهية واحتقار. هذا واقع معروف، ومن يقول بعكسه عليه أن يثبت ما يقول. والجمال لا يثبت، يقرر فحسب. ولم يُسمَع في احتجاجات الثورة السلمية الباكرة تأكيد خاص على هوية إسلامية سنية، وإن كان مرجحاً أن أكثر الثائرين ينحدرون من بيئات سنية. وحين هتف الثائرون «سوريا لينا وما هي لبيت الأسد» لم يكن المقصود أن سوريا للسنيين فقط، بل إنها للسوريين. وكان هذا الهتاف موجهاً ضد خصخصة الدولة. وخصخصة الثورة مثلما يفعل المشايخ وشارحهم ليست الرد على الدولة المخصخصة، بل هي استمرار لها. معلوم أنه حيثما سيطرة المجموعات الإسلامية التي سبقت المشايخ والشارح في خصخصة الثورة أنتجت أسدية إسلامية.
خرج السوريون احتجاجاً على ذل وطغيان، وبغرض تغير النظام السياسي القائم منذ أربعين عاماً وقتها. والسياق معلوم، هو «الربيع العربي»، وهو تمرد اجتماعي انتشر في ستة بلدان خلال أسابيع طلباً للتغير السياسي، تحفزه قيم الكرامة والحرية والعدالة، ولم يكن تعبيراً عن «هوية دينية»، وإن لم يكن منازعاً لها بحال. خرجت بعض مظاهرات السوريين من مساجد ولم تخرج بعضها من مساجد. من تجمعوا في ساحة الساعة في حمص قبل المجزرة ليلة 18 نيسان جاءوا من بيوتهم، وربما جاء بعضهم من المسجد. ومن حاولوا احتلال ساحة العباسيين في دمشق في مطالع نيسان 2011 جاءوا من البلدات والضواحي القريبة. وخرج طلاب جامعة حلب من الجامعة، وليس من الجامع. ولكان طلاب جامعة دمشق فعلوا الشيء نفسه لو لم تكن جامعتهم واقعة تحت احتلال أشد قسوة. وهو ما لا يطعن في أن كثير من المظاهرات خرجت من مساجد هي أماكن التجمع الوحيدة في سوريا. ليس هناك مقرات أحزاب معارضة أو منتديات شبابية واجتماعية مستقلة، أو نقابات مستقلة، أو قوى ديمقراطية متمرسة بتنظيم الناشط الاحتجاجي في المجتمع. الواقع أن الشبكات الدينية انتفعت دون غيرها من الطغيان الدولتي لأن الدين يجنح لأن يكون سياسة مجتمعات بلا سياسة، مجتمعات مفقرة سياسياً، ممنوعة من الاجتماع ومن الكلام والاحتجاج. في ألمانيا الشرقية وفي بولونيا قامت الكنيسة بدور مماثل ضد نظام الحزب الواحد، الشيوعي، الذي حطم المنظمات الاجتماعية المستقلة وألغى الحياة السياسية. لا يفعل الناس ذلك اليوم في أي من البلدين حين يخرجون محتجين.
وبالمناسبة، فإن الخروج من المساجد الذي يقرره الجمال هو بالذات ما يأخذه على الثورة السورية معادون لها مثل الشاعر أدونيس. ومثل الجمال يصر الشاعر الذي تفرغ للطعن في الثورة السورية (وللثناء على نفسه) على أن المظاهرات خرجت من المساجد، ويرفض أن يرى لماذا خرج ما خرج منها من المساجد، كما واقع أن مظاهرات كثيرة لم تخرج من مساجد. في الحالين لدينا مصادرة ماهوية لحدث تاريخي كبير ومركّب ومتعدد المحركات وواسع القاعدة. واحد يقرر إسلامية الثورات ليستأثر بما تعود به من شرعية، وواحد يقرر إسلاميتها كي ينكر عليها الشرعية. الاثنان طائفيان على حد سواء.
لا يلبث الدكتور أن يقرر إسلامية الهوية وصمودها في وجه العابثين طوال أربعة عقود، «فلم يستطيعوا تغيير الهوية لتصبح هويّة قوميّة أو اشتراكيّة أو بعثيّة أو شيوعيّة!» بلى، كانت الهوية قومية عربية بين استقلال سوريا وحتى سبعينات القرن العشرين، وكان التماهي العربي أقوى من التماهي الإسلامي الذي صعد بارتباط وثيق مع الحجر السياسي على المجتمع السوري، وحدوث ما يشبه ذلك في معظم المجتمعات العربية. ثم إن للموجة الإسلامية الحالية بدء، وما له بدء له انتهاء. وضمن الموجة موجات فرعية منها السلفية الجهادية وتتويجها بداعش. والدعاة الداعشيون يعتبرون الإخوان علمانيين، على ما ورد بالفعل في كتاب إدارة التوحش لأبي بكر ناجي.
ولمن قد يتساءل عن «طبيعة المجلس الإسلاميّ» الذي يشرح الجمال وثيقته، و«من الذين يمثّلهم المجلس ويتحدّث باسمهم، ويعدّ مرجعيّة لهم»، يأتيه جواب الدكتور الجمال كالتالي: «أكثريّة سكّان سوريا التي عبّرت الوثيقة عن هويّتها، فنحنُ المسلمون السنّة الذين يقطنون هذه البلاد منذ مئات السنين، ولغةُ عامّتنا هي اللغة العربيّة». ليس معلوماً متى أُعطي المجلس الإسلامي صفة تمثيلية ومرجعية، ومن أعطاه إياها، وبأي حق. لكن ما لم تصرح به وثيقة المشايخ من أن ما تعنيه بالإسلام هو الإسلام السني صرح به الدكتور في مجلة المجلس وتعليقاً حماسياً على وثيقة المجلس. وما يغفل عنه المجلس يغفل عنه الدكتور، وهو أن الأكثرية الأهلية التي يُحيلون إليها ليست موحّدة سياسياً ولا اجتماعياً ولا فكرياً ولا نفسياً، وأن ما انتسب إليها من تعبيرات سياسية كانت متقاتلة فيما بينها، وأن قطاعات منها موالية للنظام إلى اليوم، وقطاعات منها لا تُعرِّف نفسها كإسلامية ولا كسنية، بل ترتضي تعريفا وطنياً سورياً أو قومياً عربياً، وهذا دون أن تكون بالضرورة على عداء للإسلاميين، ومن باب أولى للإسلام. على أن منها ما هو معاد بالفعل، وهذا العداء يظهر بقوة أكبر كلما أخذت الإسلامية شكل الإسلامية المطلقة، ويتراجع حين تقترب من أن تكون إسلامية دستورية أو مقيدة.
وبعد أن حدد النحن على الصورة المتقدمة، يميز الدكتور الجمال بين ثلاثة أشكال لـ«الآخر»، تعزز ما تقدم استنتاجه من أن ما تنفتح عليه وثيقة المشايخ الذي انتخبوا أنفسهم مرجعية إسلامية سورية هو نظام أهل ذمة محدث. «الآخر» عموماً هو «المنتمي إلى غير هذه الهوية، من أبناء هذه الأرض الذين يشاركون الأكثرية في العيش المشترك عليها منذ مئات السنين». هل لهذه العبارة الأخيرة الدلالة ذاتها للقول: الذين تشاركهم الأكثرية العيش منذ مئات السنين؟ ذلك أن بعض «أبناء هذه الأرض» أقدم من «الأكثرية» كما يعلم الدكتور. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا هوية سوريا هي الإسلام السني، بينما «أبناء هذه الأرض» متنوعون؟ فإذا كانت سوريا وطن السوريين وجب بناء تصور استيعابي للهوية، وليس تصوراً استبعادياً يقوم على عقيدة بعض السوريين. والتصور الاستيعابي لا يمكن أن يكون دينياً. فدين البعض، وإن كانوا أكثرية، لا يمكن أن يكون هوية الجميع، ولا من باب أولى دولة الجميع.
ويُفرِّع الكاتب «الآخر» إلى ثلاثة أصناف. الآخر الأول هو «الواقف في وجه الظالمين المناوئ للبطش والديكتاتوريّة والاستئثار بالسلطة والحكم والموارد من حَمَلَة المبادئ غير المنتمية إلى هويّة هذه البلاد؛ إمّا لكونهم من أتباع ديانات أخرى كالنصيريّة والدرزيّة والنصرانيّة والصابئة، أو لكونهم من أتباع أيديولوجيات مستوردة من الشرق أو الغرب؛ الذين يرونَ تمسّك عموم الشعب بعاداته وتقاليده جزءاً من التخلّف والعودة إلى العصور الحجريّةِ، وانتماءً إلى الجزيرة العربيّة!». الرجل يتكلم على «واقفين في وجه الظالمين»، لكن فكره يسوقه سوقاً إلى الحط من شأن من ليسوا مثله منهم. إذ بعد أن سجل الدكتور والمشايخ سوريا باسم المسلمين السنيين يصير من ليس منهم غريباً، غير منتمٍ إلى هوية هذه البلاد! وضمن صنف الآخر هذا هناك صنف فرعي أول مشكَّل من علويين (نصيريين بلغة الدكتور الذي لا يبالي باسم علويين الذي ارتضوه لأنفسهم) أو دروز أو مسيحيين (يسمي الدكتور دينهم بالنصرانية) أو إيزيديين (صابئة)، ثم صنف فرعي آخر مكون من «أتباع أيديولوجيات مستوردةٍ من الشرق أو الغرب»، والأرجح أن الأمر يتعلق بمسلمين سنيين سوسيولوجياً لكنهم يساريون أو ليبراليون أو علمانيون. بما أن «الأصيل» هو الدكتور ومن يشبهه، فإن من لا يشبهه مستورد. ولا يتخيل الرجل من لا يشبهونه إلا مزدرين للشعب المتدين وناسبين له إلى عصور حجرية أو إلى الجزيرة العربية. هناك أصوات من هذا النوع بالفعل، لكنها في صف النظام وليس من طرف الثورة عليه، ولهم التكوين المتعصب، وفي الغالب الطائفي، الذي هو تكوين الدكتور.
يستخلص الجمال أن هذا الصنف الأول من الآخر «لا يمكن أن يكون منتمياً إلى الهويّة انتماءً مباشراً، وإن كان منتمياً إلى وصفَي العربيّة الإسلاميّة أو أحدهما بمعناه العام الذي يشكّل العمود الفقريّ في هذه الهوية، وإن كان هؤلاء منتمين إلى الثورة أيضاً». لا يكفي أن يكون المرء عربياً مسلماً، ولا يكفي أن يكون منتمياً إلى الثورة السورية، ينبغي أن يتبع ملّة الدكتور حتى ينال الرضا.
الآخر الثاني هو «الذي لم يعترض على الظالم اعتراضاً مباشراً، ولم يمنعه من ظلمه، ويُظهِرُ نفسَه معتدلاً غير مشاركٍ في الإثم والعدوان على الأكثريّة، وهم كثير من أبناء المناطق التي بقيت تحت سيطرة النظام من السنّة وغيرهم من المنتمين إلى الهويّة من حيث الأصل، المبتعدين عنها من حيث الممارسة والسلوك». تُرى لم لا يقال لنا بوضوح إن الإسلاميين السنيين ذوي التكوين الإخواني أو السلفي أو السلفي الجهادي هم الهوية، وليس حتى عموم المسلمين السنيين؟
الآخر الثالث هو «الموافق للظالمين، الذي شارك في قتل الأكثريّة ومحاولة تغيير هويّتها ديمغرافيّاً وعسكريّاً وثقافيّاً». بعض هذا الآخر، على ما لا يخفى على الدكتور، من «الهوية السورية الأصيلة»، مسلمون سنيون، وهو ما من شأن التبصر فيه أن يحيل إلى توزيع سياسي للآخرية إن جاز التعبير، توزيع أكثر عدالة وإنسانية، دون أن يكون متعامياً بالضرورة عن الطائفية والتمييز الطائفي.
ويقرر الجمال أن «الواجب الشرعي» يقضي «بقبول الصنف الأول والثاني من الآخر في إطار الوطن، والتعامل معهم في نطاق الحقوق والواجبات كما نتعامل تماماً مع من ينتمي إلى الهويّة نفسها انتماءً حقيقيّاً كاملاً… فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، من البرّ إلى محسنهم ومنع مسيئهم من الإساءة إلى الدين أو الهوية أو المجتمع، والأخذ على يد المعتدي». الكاتب يضع نفسه وهويته في موقع السيد، واضع القوانين والديّان على الناس. وهو، الإسلامي السني، يقرر من يقبل ومن لا يقبل. وبطبيعة الحال هو من يُعرِّف من هو المحسن ومن المسيء، ما يضع عموم غير الإسلاميين السنيين في ذمة أمثال الدكتور، لا يعرف الواحد منا متى يجد أشباه السيد في أقوالنا وأفعالنا ما يسيء، فنعتصم بالصمت أو نهجر البلاد مثلما فعل سوريون كثيرون في ظل الحكم الأسدي. ما سنحصل عليه من سيادة هوية المشايخ والدكتور هو أسدية إسلامية سنية، لا أكثر ولا أقل.
يستأنف الجمال كلامه عن معاملة «الآخر» بالقول: «وليس من المقبول أن نتنازل عن ثوابتنا أو نطمس هويتنا تحت شعار رعاية الآخر والقبول به، ولا من المطلوب منا شرعاً أن نغيّر أحكام ديننا من أجل أن يقبل بنا الآخر! الذي لا يمثّل هوية المجتمع». يتكلم الأخ كأنه صاحب البيت في سوريا، و«الآخر» أو الآخرون غرباء حلوا عليه ضيوفاً ثقلاء. ترى ما يكون الحال معه لو لم يكن لاجئاً في تركيا، وكان حاكماً في سوريا؟
أما الآخر الثالث فيريد الجمال محاكمته محاكمة عادلة، والعدالة هي فرض قانونه هو أو شريعته هو على غيره. إذ بالطبع لا يجوز أن يتنازل عن ثوابته.
فإن لم يتضح ما يريده شارح وثيقة مشايخ المجلس الإسلامي السوري عن هوية السوريين إلى الآن، يزيدك الشارح بياناً: «قبول الآخر لا يعني أن يأخذ حقوق الأكثرية، ولا يعني أن نقتنع بفكره ونغيّر هويتنا تماشياً مع رأيه ووجهات نظره، ولا يعني عدم بيان ما في فكره من مفاسد من وجهة نظر الأكثريّة الذين يشكّلون هذه الهويّة». ولكن من قال لك أن تغير شيئاً من نفسك أو ما بنفسك يا سيد! المشكلة معك ليس في أنك لا تريد أن تتغير، فهذا شأنك، بل في أنه لا يهنأ لك عيش دون أن تفرض معاييرك وأفكارك على غيرك باسم ما تزعم من هوية أصيلة؛ المشكلة أنك تريد من غيرك أن يقبلوا سلطانك وسيادتك، فلا يظهروا أفكارهم وعقائدهم أو يعبروا عنها، ولا ينتقدوك، ولا يقولوا إنك مستبد أرعن أو طائفي متعصب أو متسلط فاسد، وهذا مثل حالنا تماماً في ظل حكم الأسديين! المشكلة أنك تريد لـ«الآخر» أن يكون مواطن درجة ثانية أو أقل، ذمي، يحق لأشباهك بيان ما في فكره من مفاسد بحسب فكرتك عن المصالح والمفاسد! وبطبيعة الحال لا يمكن التفكير في أن للآخر المنكود الحق في بيان ما في فكرك من مفاسد وتمييز وتعسف. الأرجح أنه سيفقد رأسه أن جالت فيه فكرة كهذه. الجمال يعرف مثلما يعرف المشايخ كل ما هو حق، وله ولهم الحكم على جميع الناس لأن السيادة لهم، ولهم الحق دون غيرهم في ألا يكون مساوين لغيرهم.
وبلا مناسبة، يختم شارح وثيقة المجلس الإسلامي السوري مقالته بالقول: «إنّ الدعوات إلى النسوية وإلى الجندر وإلى قانون الزواج المدني المخالف للشريعة الإسلامية هي دعوات لإنكار الهوية والبعد عن الذات، وفي مؤدّاها دعوات إلى الانحلال الأخلاقيّ الذي لا يمكن أن يتوافق مع الهوية السوريّة الوطنيّة». يصعب التعليق. قبل كل شيء يتساءل المرء إن كانت هذه اللغة الغوغائية المُسفّة لغة «أستاذ الدراسات العليا في جامعة إسطنبول» على ما جرى تعريف الرجل في المجلة (دون توضيح لحقل دراساته… العليا)، فما تكون لغة المتعلمين على يديه؟ وهل يعسر عليه أن يفهم أنه في مجتمعاتنا المعاصرة، مثل كل المجتمعات، أخلاقيات متعددة، وأن الصراع الفكري والقيمي الحقيقي عندنا وعند غيرنا هو بين أخلاق وأخلاق، وليس بين أخلاق ولاأخلاق مثلما أوهمته ميلودراماه الدينية؟ وأن «النسوية والجندر والزواج المدني» تندرج ضمن أخلاقية أساسها الحرية وسيادة الناس، نساءً ورجالاً، على أنفسهم، ويعرض معتنقوها شجاعة وحساً بالعدالة يفوق ما يعرضه الدكتور، فضلا عن أفق معرفي أوسع؟ وأن الشريعة الإسلامية هي أخلاقية بين أخلاقيات ممكنة، وأن محتواها الأخلاقي ينحدر بشدة كلما فرضت بالقوة؟ وإذا كان بيان المحاسن والمفاسد حقاً متاحاً للجميع، ولا شيء يكون حقاً إن لم يكن قابلاً للتعميم، فسيجد كثيرون وبحق أن في الزواج المتعدد للرجل تمييزاً غير عادل بين الرجال والنساء (تشهد به كل امرأة مسلمة حين تكره زواج رجلها بأخرى)، ويحق للنساء والعادلين من الرجال الاعتراض عليه. النسوية متكونة حول مطالب من هذا النوع موجهة ضد امتيازات الرجال والسلطة الذكورية. إنها دعوة للعدالة وليس للانحلال الأخلاقي على ما يضلل الدكتور غيره ونفسه. والزواج المدني مبني على مبدأ أن الزواج علاقة بين فردين، وليس بين دينين أو طائفتين، وأن الفردين هما من يقررانه. هذا أكثر توافقاً مع الحرية والعدالة، وإن لم يكن ما تفضله سلطات دينية. وهو بلا شك غير منحل أخلاقياً خلافاً لما يفتري الجمال.
والطريف والدال أنه عند التدقيق في آخرَي الجمال الثلاث نلاحظ أن الآخر الأول، المشارك في الثورة، و«المناوئ للبطش والديكتاتوريّة والاستئثار بالسلطة والحكم والموارد»، هو من يربك وجوده الدكتور أكثر من الآخرين الثاني والثالث، «الصامت» و«الموافق للظالمين». وهو يستخرج من قبو قومي إسلامي متعفن عبارة الإيديولوجيا المستوردة، وينسب الثائرين غير السنيين إلى مذاهب ونصيرية ونصرانية وصابئة، فضلاً عن سوء ظنه بهم واعتقاده بأنهم يرمون المتدينين بالتخلف أو بالانتماء للعصر الحجري… الدكتور يغص بالثائرين من غير الإسلاميين ومن غير السنيين لأن لهم قولاً متماسكاً غير قوله، وحضوراً مؤثراً لا يستأذن حضوره، وشرعية ذاتية لا تنتظر إقراره. ولأنه يمثلون بوجودهم سوريا منفتحة ومتعددة وحيوية وحرة، ممتنعة على التعليب الديني. كان يتمنى لو أن جميع غير السنيين كانوا إلى جانب النظام، إذاً لاستقر عالمه وطابت هويته، وأخذ كامل راحته في تعظيم الذات واغتياب الغير.
الروحية العامة لمقالة الجمال الشارح تتسم بالشح والتزمت. ليس هناك ترحاب أو مودة أو استضافة للغير في النفس. هناك بالعكس تجهم وتشرُّط وتضييق. هذا الخلو من السماحة والكرم ملمح يتجاوز مقالة الجمال إلى أوسع أطياف الإسلاميين، وقد تقدمت الإشارة إلى سمة أخرى لخطابات الإسلاميين تتمثل في مديح النفس والثناء على النفس وتعظيم النفس. ومقابل ذلك لن يجد المرء عند الإسلاميين كلمة طيبة بحق دين آخر أو فكرة أخرى أو مذهب اجتماعي آخر، ولا تضامن مع قوم دهمتهم كارثة طبيعية أو سياسية، وهذا مع رخصة مستمرة للنفس بتقييم جميع الناس والحكم عليهم.
لدينا طرف سوري خاص، وهو مهزوم وتابع اليوم، يعلن لعموم السوريين، للمهزومين مثله، كذلك للمنتصرين عليه، أنه لا يريد المساواة مع أي منهم، وأنه يعتزم تحكيم نفسه فيما يشجر بينهم وبين غيره منهم، وأنه في الحقيقة خير منهم ومن الجميع، وأنه هو (هذا الطرف الخاص) هو «الهوية» العامة، وهو الأكثرية، وهذا في نفس واحد بعد أن كان حط من شأن ما لا يقل عن ثلثي السوريين في آخريه الثلاثة! أليس هذا بالفعل أصلح تعريف للتطرف؟ إذ ما التطرف إن لم يكن احتلال طرف بعينه محل الكل، وإشغال موقع جميع الأطراف؟
تكوين الإسلامية الفكري والأخلاقي
يبدو شاغل «الهوية» عند المشايخ والشارح تعويضاً عن الأرض، عن ارتباط بمجتمع مستقر وبيئات حية. الإسلامية السورية اليوم إسلامية شتات، معرضة بقوة أكبر لما ميز الإسلام المعولم من تجريد وتطرف بفعل انفصاله عن المحلي، وإقامته الاضطرارية في الماضي. ويبدو هذا من وجه آخر أحد أوجه النكوص العام الذي أصاب المجتمع السوري في الحقبة الأسدية: التحول السلطاني، والأبد، وفقدان الوجهة، والمستقبل.
تثير وثيقة مشايخ المجلس الإسلامي السوري في إسطنبول وشرح شارحهم تساؤلات محيرة عن حس الواقع عند الإسلاميين. تكررت الإشارة فوق إلى تعارض شاسع بين الوضع المتداعي لبيئات الإسلام السني السورية وبين الخطاب العاتي والمغرور للناطقين المفترضين باسمها، بين «الأفول السني» والاكتفاء الذاتي الذي يعرضه المتكلمون السنيون، وهو ما لا يغذي غير مزيد من الأفول. كأنما هناك «غريزة موت» تعتمل في تكوين الجماعة، كأنما هناك نازع لتدمير الذات بفعل عدم القدرة على التكيف الفاعل مع البيئات الحديثة أو مجرد استيعاب الواقع الفعلي. وكأن الجماعة فوق ذلك صفحوا عالمهم بدروع صفيقة تحول دون الحس بتعدد الواقع وتعقده، وإجراء الانعطاف الضروري لتجنب الكارثة المتكررة. تكوين الإسلامية السنية في سورية انتحاري، والأرجح أن منبع المنزع الانتحاري هو صورة عن الذات متناقضة كلياً مع الواقع، والقصور الذي تعرضه نخب الإسلاميين في مراجعة الماضي والراهن باتجاه قدر من التواضع والاستعداد للتعلم. «الأكثرية السنية» محتاجة إلى حماية من النزعات الانتحارية لنخبها أكثر من أي شيء آخر.
التكوين الفكري للإسلامية السورية بأجنحتها المشايخية والإخوانية والسلفية والسلفية-الجهادية، هو تكوين إسلامي تقليدي بصورة حصرية. علاقتهم بالفلسفة والعلوم الاجتماعية تتراوح بين العداء والعدم. بالعلوم الطبيعية إنتاجاً وتجريباً ومساهمة معدومة. بالأدب والفن غير الإسلامي – وربما العربي القديم – مثل ذلك وأكثر. ثم إنه في تأهيلهم الإسلامي بالذات، يغلب الفقهي، رغم أننا اليوم في وضعية كلامية تستدعي إعادة التفكير في الله والخير والشر والقضاء والقدر وحرية الإنسان. علم الإسلاميين في عالم اليوم محدود وقابل للختم، و«العلماء» هم خاتمو هذا العلم. والعالم المتكون حول هذا العلم القابل لأن يُختم ضيق مثله. ورغم هذا التكوين الخاص، الضيق والانعزالي، ينسب الإسلاميون إلى أنفسهم صفة عامة، صفة الهوية العامة وصفة الجدارة بالحكم والدولة العامة. هنا ثمة تناقض كبير بين التكوين الخاص الضيق والمتزايد الضيق وبين إرادة العام الذي يفيض عليهم من كل جهة، بفعل تشكله عبر انخراطنا الواجب والمحتوم في العالم الحديث والمعاصر. هذا التناقض بين خصوصية متصلبة لتكوين الإسلاميين وبين تطلعهم للعام الأعلى سياسياً وفكرياً لا يمكن حله بغير مصادرات لفظية على طبيعة إسلامية ثابتة لمجتمعاتنا، أو بعنف لا يُحَد يتخلص أولا بأول من كل من قد تخامره فكرة أخرى. عنف داعش ليس حتماً ممارسة شخصيات سادية مريضة، بل هو وليد علم وعالم ضيقين، لم تتجاسر الإسلامية المعاصرة على القول إنهما انعزال وانتحار. وليس سمير كعكة، وهو «شرعي» جيش الإسلام أي مفتي الجريمة فيه، شخصاً منحرفاً موتوراً أسود القلب حتماً، لكنه ضحل ومبتذل، يشعر أنه «مرجع» حين يختم «علماً» محدوداً جاف الروح، يقول له أنه صح وغيره خطأ، ولأنه صح يحق له أن يكره، بل أن يؤذي من ليسوا مثله (ماذا تقول عقيدة الولاء والبراء غير ذلك؟). الجريمة تصير طاعة، والشر يصير خيراً، على هذا النحو الذي نحاه ما لا يحصى من إسلاميين في العقود الأخيرة. كعكة مجرم بفعل تمام علمه، وليس لنقصه، وهو متشكل بعلمه/عالمه الضيق المفعم بالكراهية الذي لا يوجد فيه إلا أمثاله، فلا حوار ولعلنا نستدل من ذلك على أن أكبر الشر يأتي من طرف من يُحكِّمون عقائدهم الخاصة المعزولة عن النقاش العام في الحياة العامة، أو من لا يستأذنون غير «الواجب الشرعي» في معاملة من هم من خارج عصبتهم على طريقة أستاذ الدراسات العليا المذكور فوق. إذا كانت التجارب الإسلامية تقتضي العنف ضد المجتمع وتبتدئ به فلأنها خاصة وضيقة، ولا يسعفها تكوينها المغلق هذا لمعالجة مشكلات حديثة مركبة في مجتمع مفتوح وعالم مفتوح.
وما أريد الخلوص إليه هو أن الإسلامية اليوم لا تشبه بحال سلطان الإسلام في أزمنة ما قبل التنظيمات العثمانية، لكن محرومة من السلطة. كانت سلطنات المسلمين العثمانية وما قبلها بنت زمنها بقدر كبير، وحدث أحياناً أن كانت طليعية هنا أو هناك. كان علمها علم وقتها وكذلك ممارساتها وقيمها ومؤسساتها وتقنياتها. لم يعد الأمر كذلك اليوم، علم الإسلامية محدود، ونظرتها للعالم ضيقة، وممارساتها انعزالية، وقيمها غير متجددة، وكل من يتطلع إلى معرفة أغنى وحياة أكرم وحرية أوسع وكفاءة أكبر لا يجدها في كنفها، بل في العالم الحديث على علاته الكثيرة بالفعل. عالمنا الإسلامي معتل أكثر وعقيم أكثر ومغلق أكثر وعنيف أكثر. إذا صارت الأكثرية التي يتكلم عليها المشايخ والإسلاميون أقلية، فليس فقط بفعل وحشية نظام استبدادي طائفي، ولا بفعل حماته الطائفيين مثله، وإنما كذلك بفعل التكوين الخاص والضيق لقيادات الإسلام السني «العلمية» والسياسية. أي بفعل قصور ذاتي كبير عند نخب الإسلام السني، معزز باكتفاء هذه النخب بقليلها الموروث الذي تتفاقم قلته بفعل اتساع يومي للمحسوس والمعقول في العالم الحديث والمعاصر. ومن يقلل نفسه بنفسه على هذا النحو يصير أقلية اجتماعياً وسياسياً، يتطيف.
وغير التقليل الذاتي الناشئ عن التخاذل والافتقار إلى الشجاعة، تمعن عقائد الإسلاميين في الغرابة والاعتباطية في عالم اليوم. القصة التي يرويها القوم لأنفسهم ولنا هي أنهم أهدى من الجميع، وأعدل من الجميع، وأعلم من الجميع، وخير من الجميع، وأحق من الجميع بالسيادة والسؤدد في مجتمعاتنا والعالم، وأن لهم فرض عقائدهم وشرائعهم على الجميع بالقوة، وهذا لأن الله، الأقوى من كل قوي، قال لهم أن يفعلوا ذلك! ولا يبدو واقع المسلمين البائس، وقلة إنتاج الإسلاميين من الحق والسلم والسكينة والمعرفة والروح والضمير والمعنى يوفر لهم شواهد على بطلان القصة واعتباطيتها.
في غيبة علم كلام جديد ودون فلسفة ودون إنسانيات، ودون تدرب أخلاقي على وضع النفس في موقع الغير والنظر إلى النفس بعين الغير، تمعن عقائد الإسلاميين في الغرابة والشذوذ، بقدر ما هم يمعنون في التحول إلى طائفة خاصة، قليلة معنوياً وفكرياً وأخلاقياً، وإن كثيرة العدد. ورغم افتراض صفة إسلامية جوهرية لمجتمعاتنا فإن مجموعات الإسلاميين لم تسيطر حيثما سيطرت إلا بالاعتقال والاغتيال والتغييب والتعذيب. وهذا بالضبط بسبب غرابة العقيدة وطائفية الجماعة.
وفضلاً عن ديناميكية تقليل طائفي وعن عقيدة غريبة تطلب لنفسها حق الإكراه (والكره للجميع كذلك)، لا تعرض الإسلامية المعاصرة حساً أخلاقية يبعث على الثقة. رأينا أعلاه أستاذ الدراسات العليا يحيل إلى «الانحلال الأخلاقي» ما لا يوافق اعتقاده الذاتي الذي يرفع فوق غيره درجات. لكن أليس الأستاذ بالأحرى مدافعاً عن امتيازات دينية وذكورية غير عادلة، وهو يجرم من يناضلن ويناضلون من أجل العدالة للنساء ولغير المسلمين من أجل مصلحته الطائفية؟ وهل عن غير تكوين أخلاقي مثل تكوين الأستاذ، يشرع للنفس حق اغتياب جميع الناس، تصدر الأحكام السفيهة لشبيه للأستاذ، هيثم المالح، عن لباس «غير محتشم»، لمغيَّبة على يد إسلاميين، وربما شهيدة، مثل رزان زيتونة؟ هل كان يمكن أن يقول ذلك لولا إدمان الغيبة والنيل من الأعراض مما يثابر الإسلاميون على ممارسته؟
فإذا عرفنا مجال الأخلاق بحب الخير مبدئياً، والالتزام بذلك في التفاعلات مع الغريب والقريب من البشر، وتوخي العدالة في معاملة من آذاك، فإن ما يؤخذ بحق على الإسلاميين هو طائفية أخلاقيتهم، تحصر فعل الخير في الجماعة وتبيح الشر حيال الغريب. فهم قلما يحسنون لغيرهم، ولا يرجون الخير لغريب لم يؤذهم، وبعض جماعاتهم توجب كره غير المسلم لمجرد أنه غير مسلم، وفي صيغ أخرى توجب إيذاءه. هذه عصبية طائفية، تحتفي بأخلاقية متدنية ولا-إنسانية، ولا تؤسس لاجتماع بشري معافى. التكوين الفقهي للإسلامية المعاصرة وآلية الفتوى المعتمدة في أوساطها تتوافق مع أسلمة الشر، أي إضفاء شرعية إسلامية على أفعال وانفعالات الملأ الإسلامي، وهي تتراوح بين غير ودودة حيال وبين العداء الشديد لكل غير المسلمين وكل غير الأشباه من المسلمين. فعل الخير يقتضي تكويناً نفسياً فكرياً محباً للبشر وإيجابياً حيال العالم، وليس في الإسلامية المعاصرة شيء من هذين. وبطبيعة الحال أسلمة الشر لا تغير الشر بل تغير الإسلام، تجعل منه عقيدة معدومة الشخصية تبرر مسالك مستخدميها الأشرار أياً تكن. ظاهرة المجالس الشرعية و«الشرعيين» الذين انتشروا كالوباء بعد الثورة السورية، تعكس بالضبط أسلمة الشر، تشريع فعل قتلة كانوا يسمون الأمنيين.
وبعد، لا تقتضي هذه المناقشة إنكار فروق سياسية ضمن طيف الإسلاميين تحيل إلى المنشأ المختلف، وبقدر ما إلى إطار العمل (محلي، دولي، معولم)، لكن يبدو أنه يمتنع للاعتدال الذاتي المحتمل لأي إسلاميين أن يترجم إلى اعتدال سياسي علني دون الخروج من نموذج إسلامية التطبيق المطلقة إلى إسلامية دستورية غير تطبيقية، تستلهم القيم الإسلامية العامة من عدل وتوحيد وتقوى وأخوة وحسن معاملة… ولعل هذا يقتضي النظر بإمعان في تكوين الضمير الإسلامي السني المعاصر، وهو قائم على المظلومية واحتكار المعاناة من جهة، ثم على التفوقية السنية القائمة على الميراث الإمبراطوري واحتكار الله، وهما يؤسسان معاً لما يمكن تسميته الظالمية الحلال أو الشرعية، ثم نزعة الاكتفاء الإسلامية التي تمضي من القول إن كل ما لدينا حق إلى القول إن كل ما هو حق لدينا، أي بالضبط الظلامية. هذه العناصر الثلاث تجمع بنسب تتفاوت بين الإسلاميين المختلفين، وتشكل ركائز نفسية وخيالية لإسلامية التطبيق التي لا يقوم عليها غير حكم استبدادي مطلق. ويستبعد بعد ذلك أن نكون حيال استبداد تقليدي يستأثر بالسلطة ويفرض صبغة دينية على الحياة العامة، ولكنه سطحي في اختراقه للمجتمع. بالعكس، يرجح لاستبداد ديني اليوم أن يؤسس لحكم تفتيشي، تشرف عليه أجهزة حسبة فاشية من صنف رأيناه عند داعش وجيش الإسلام وجبهة النصرة، ويعمل على إذلال نخبوي منظم لعموم السكان.
إسلام بلا شكل
لا يبدو أن الجمال ولا المشايخ من قبله أخذوا علما بظهور داعش وجبهة النصرة وجيش الإسلام، وهي منظمات سنية جمعت بين الدين والسياسة والجريمة، تماماً مثل شبيحة الحكم الأسدي. يبدو أنه يمكن للمشايخ وشارحهم قول الأشياء نفسه قبل هذه الظهورات الوحشية وبعدها، وأنه ليس لها أدنى تأثير على طريق الكلام على «الهوية» وعلى «الإسلام». لا يبدو التاريخ مُحَكِّماً ولا التجربة مُحَكِّمة عند الإسلاميين، المُحَكِّم هو شهادة اعتقادهم الذاتي لنفسه. تظهر هذه الشهادة المحابية للذات بطبيعة الحال في القول المتكرر: المشكلة ليس في الإسلام، بل في المسلمين! وهذا حين يواجه إسلاميون أو مسلمون متدينون بجرائم الإسلاميين. ليس غرض الكاتب قول العكس، الغرض بالأحرى هو إظهار لا معنى هذا القول. حين يقول مسلمون إنهم هم المشكلة وليس دينهم، فإما أن يكون قولهم عن أنفسهم صحيحاً، وفي هذه الحالة كيف يؤخذ بكلامهم عن دينهم أو عن أي شيء آخر؟ وإما ألا يكون صحيحاً، ويتعين في هذه الحال الاضطلاع الجدي والشجاع بالتوترات والمشكلات المتولدة عن وضع الإسلام في العالم المعاصر، والتي تدفع مسلمين إلى قول غريب كهذا. الإسلام اليوم فاقد للشكل إلى درجة أنه يمكن نفي كل شيء عنه (الإسلام من ذلك براء!) وتبرير كل شيء به (استطاع قتلة ولصوص وكذابون من كل نوع فعل ذلك) في الوقت نفسه. فقدان الشكل هذا تعريف صالح للمشكلة، ولن يكون للإسلام شكل، فيكف عن كونه مشكلة، بدون جهد إعادة تشكيل واسع، يقوم به الحريصون على دينهم. جهد كلامي وفلسفي وأخلاقي، وليس فقهياً إفتائياً لا مؤدى له غير أسلمة الشر، وغير نظرة مفتتة وتجزيئية للعالم لا تحيط بعمليات تكونه وتحوله.
وما لا يبدو أن مجمل التفكير الإسلامي المعاصر يتبيّنه هو أنه إذا كان لا تمايز بين الديني والسياسي في الإسلام، فإن الجرائم السياسية التي يرتكبها إسلاميون، مثل ثالوث الشر المذكور فوق (داعش وجبهة النصرة وجيش الإسلام) هي جرائم دينية كذلك، يُساءل عنها دينهم، وأن المعنيين بكرامة الإسلام مخيرون بين أن يرفضوا تطابق الديني والسياسي، أي أن يرفضوا الإسلامية المطلقة ويعتنقوا إسلامية دستورية، وبين أن يقبلوا أن جرائم القتل والخطف والتعذيب هي جرائم دينية فوق كونها سياسية، وعندئذ من حق المرء أن يتساءل: إذا كانت الجرائم مقبولة ديناً على هذا النحو، فلماذا يا ترى الكفر هو السيء؟
هناك تخاذل إسلامي عن مواجهة المشكلات التي تنشأ حتماً من الوجود في عالم متغير، وتؤدي إلى فقدان الشكل، وتقتضي بالتالي فكراً مبدعاً حراً متجدداً واسع القاعدة من أجل تطوير شكل حي. وتجري التغطية على الافتقار إلى الشجاعة بالقول إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. هذا باطل. لا شيء يصلح لأزمنة متغيرة وأماكن متغايرة إلا ما يتغير. وما لا يتغير لا يصلح لأي وقت ولا لأي مكان. تواتر نماذج الإسلاميين الإجرامية، وغياب نموذج ناجح يمكن البناء عليه، يشير إلى الحاجة الملحة إلى إعادة تشكيل واسعة للمجمل الإسلامي تتيح له أن يحيا ويتجدد. ماذا يحول دون إعادة التشكيل أو الهيكلة؟ اعتياش كثيرين على القديم الجامد الذي لا شكل له، يدر عليهم سلطة ونفوذاً ووجاهة. المشكلة هي في هذا الملأ الإسلامي. والمشايخ وشارحهم نماذج ناطقة.
موقع الجمهورية
———————————-
إدارة التوحُّش/ ماهر مسعود
ظهر مشروع “إدارة التوحّش” بوصفه مشروعًا سلفيًا جهاديًا قاعديًا، تقوم فكرته على إدارة الفوضى الناتجة عن انهيار قبضة السلطات الرسمية في دولةٍ ما، أو انحلالها في منطقة معينة، عربية أو إسلامية. وتمَّ التنظير الفكري لهذا المشروع، في كتاب حمل العنوان ذاته، نُشر عام 2004، بتوقيع الإسلامي العروف بـ “أبو بكر ناجي”، يشرح فيه الكاتب إستراتيجية تنظيم قاعدة الجهاد، وهي إستراتيجية شاملة للتحوّل نحو جهاد الأمة وبناء الدولة الإسلامية. ثم انتقل المشروع إلى حيّز التطبيق، مع سيطرة تنظيم (داعش) على شرق سورية وغرب العراق، وإقامة “الدولة الإسلامية” بين عامي 2013 – 2019.
لكن ذلك المشروع الذي فشل، جهاديًا وإسلاميًا، بجهود التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، لم يعد مشروعًا إسلاميًا بأي حال، بل تمّ “تبنيّه” أميركيًا ودوليًا، وأصبح هو المشروع الوحيد المعتمد دوليًا اليوم، لإدارة الفوضى والتوحّش الحاصل في سورية والتعامل معها. ولم يبق للدول الكثيرة المتدخلة في سورية، والتي لم ينتصر أي منها بشكل نهائي، إلا التعامل مع الجحيم الذي يعيشه السوريون، بوصفه واقعًا متوحّشًا ومفتوحًا وبلا نهاية واضحة في الأفق. وكذلك لم تعُد سورية، في عين جميع المتدخلين الوقحة، إلا ميدانًا لتصفية الحسابات وتحصيل الامتيازات في أماكن أخرى، بوصفها أرضًا “للدماء والرمال” والجوع والانحطاط، والحروب الدولية بالوكالة، أو ما يمكن تسميته بـ”الحرب الأهليدولية” القائمة هناك.
النظام السوري الذي اعتاش على الوحشية، وصنعها ومارسها باحترافية لا تُضاهى، يبدو كالمَصبّ الذي تصبُّ فيه المياه القذرة لجميع الدول المتدخلة، على اختلافاتها وتناقضاتها وعداواتها المتباينة، مثلما يبدو طرفًا خارجيًا للجميع، فهو من جهة غير متأثر على الإطلاق بالجحيم المعيشي الذي يعانيه السوريون من جرّاء الحرب والعقوبات والفقر والتهجير والوباء والموت المجاني، وغير متأثر من جهة أخرى بالصراعات وتصفية الحسابات التي تحصل بين أميركا وروسيا، إسرائيل وإيران، تركيا والأكراد، دول الخليج وإيران وتركيا.. إلخ. هو “الجوكر” المنفصل و”المستقل” عن الجميع، في الوقت الذي يستخدمه الجميع كورقة للضغط والضغط المعاكس، فلا بديل عنه بالنسبة إلى القوى الغربية التي لم تقم بأي جهد جدّي أو حقيقي لصناعة ذلك البديل، ولا بديل عنه بالنسبة إلى روسيا وإيران اللتين بذلتا أقصى الجهود العسكرية والسياسية لقتل أي بديل ممكن في مهده.
منذ أن تراجع أوباما عن خطّه الأحمر، واختار عدم التدخل عام 2013، ومنع الآخرين من تزويد المعارضة بمضادات الطيران أو إقامة مناطق آمنة أو حظر طيران أو ما شابه، باتت جميع أنواع التدخل الأخرى في سورية “مشروعة”، وبات الدور الأميركي الأساسي هناك هو إدارة تلك التدخلات، إعاقة الآخرين ومنعهم من الانتصار، “إغراق” الروس في أوحال سورية، ثم تحميلهم مسؤولية الدماء والفشل الأخلاقي للهروب من تلك المسؤولية، سحب الإيرانيين للتفاوض على الملف النووي مقابل السيطرة الإقليمية، تحجيم تركيا، حماية الأمن القومي الإسرائيلي، منع انتصار الثورات التي تحمل “إمكانية” انتصار الإسلام السياسي ديمقراطيًا، والأخطار التي قد يعنيها ذلك الانتصار في المحيط الإسرائيلي، ولا سيما بعد التجربة المصرية الطازجة وقتها التي نقلت الإخوان إلى الحكم عام 2012، وقبلها تجربة (حماس) عام 2006، وقبلهما التجربة الأكبر مع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
منذ أوباما، إذًا، لم يعد لدى الأميركيين، ولدى الأوروبيين، أي مشروع “إيجابي” بنّاء في سورية، وبات وجودهم هناك يتحدد بالمعنى السلبي فقط، أي المنع والإعاقة والابتزاز. فليس لديهم أي إستراتيجية خاصة ومحددة بسورية على الإطلاق، وهذا يعني أن انعدام الإستراتيجية أصبح هو الإستراتيجية المتعلقة بسورية، وأن سورية نفسها أصبحت مجرد عتبة وأداة لتحقيق إستراتيجيتهم الخاصة بـ “أمن إسرائيل”، والتي يدخل ضمنها بالطبع الملف النووي الإيراني، ففي غمام الشرق الأوسط، لا يوجد ما هو واضح إستراتيجيًا للقوى الغربية مثل “أمن إسرائيل”.
الفكرة الحاكمة لإدارة التوحش، بالمعنى الإسلامي، هي فكرة عدمية بالمطلق، إذ لا يمكن إعادة إنتاج دولة خلافة إسلامية دون عكس اتجاه الزمن، وتدمير حياة المسلمين في الحاضر، ودفعهم بالقوة للعيش خارج العصر وخارج التاريخ. ولكن عكس اتجاه الزمن أمرٌ يستحيل تحقيقه واقعيًا، بل لم تؤد محاولات تحقيقه، في أفغانستان أو العراق أو سورية، إلا إلى خلق واقع جحيمي “متوحّش” للمسلمين أنفسهم هناك، هو واقع جعل من شروط حياتهم بهيمية متوحشة، وقيمة حياتهم خارج الحسبان وما قبل إنسانية، بالإضافة إلى كونه واقعًا يتناقض بالمطلق مع الحلم الإمبراطوري الذي ارتبط بالخلافة وبالدولة الإسلامية المنشودة.
العدمية هنا -بهذا المعنى- هي النتيجة المنطقية لذلك الشرخ الواسع واللانهائي، بين الحلم الطوباوي بخلافة إسلامية عادلة تعيد القوة والكرامة والسيطرة التي عاشها المسلمون الأوائل في عين أصحاب تلك المشاريع ومخيالهم، وواقع الضعف والانحطاط والتأخر الإسلامي الذي يعيشه ويعاينه أولئك الطوباويون المرضى أنفسهم.
بكلام آخر: إن العدمية الإسلاموية هي نتيجة للإصرار القهري “الانتحاري” على تحقيق حلم مستحيل التحقيق بطبيعته، لسببين: الأول لأنه حلم مناقض بالمطلق للواقع الذي يعيشه الحالمون؛ والثاني لأنه حلم نوستالجي يريد تحطيم الحاضر للعيش في الماضي وجعل ذلك الماضي هو المستقبل. والنتيجة الحتمية لحلم كهذا، بالمعنى الفردي أو الجمعي، هي تحطيم الذات والعالم معًا، وبالتالي التوحّش.
الوجه الآخر للعدمية هو الوجه الحاصل في سورية برعاية المجتمع الدولي، وهو على العكس تمامًا من العدمية الإسلامية. فإذا كان ما يقود العدمية الإسلامية هو تحقيق غاية مستحيلة، فإن ما يقود العدمية الدولية هو انعدام وجود أي غاية خاصة بسورية على الإطلاق. بكلام آخر: إن العدمية الدولية هي المحصلة الصفرية الناتجة عن تناقض غايات المتدخلين الدوليين في سورية، من دون أي قدرة أو إرادة أو إستراتيجية واضحة المعالم لإنهاء الصراع القائم منذ عشر سنوات. ومن هنا، يلتقي الطريقان الإسلاموي والدولي في مكان واحد، على الرغم من تناقضهما الظاهر، ويجتمعان على غاية واحدة هي “إدارة التوحّش”. فبين المشروع الإسلامي المستحيل، و”اللامشروع” الدولي، لا يبقى -كمحصلة- سوى العدمية، ولا ينتج عن العدمية سوى اليأس والتحطُّم الذاتي وفقدان الأمل، وهذا بالضبط ما يعيشه السوريون على أرض سورية وخارجها.
هل هناك سبيل عقلاني للخروج من تلك العدمية المركّبة، إسلاميًا ودوليًا، والتوحّش المصاحب لها، إقليميًا ومحليًا؟ الجواب الواضح هو لا. الأرجح هو أنها “باقية وتتمدد”.
مركز حرمون
———————————
درس لا ينسى!/ أكرم البني
ربما بسبب حساسية الأمر، فشل المتحاورون، للمرة الأولى، في بناء توافقات تمكنهم من الخروج بموقف موحد من تنامي دور جماعات الإسلام السياسي في الحراك الشعبي، كان ذلك منذ عشر سنوات، وفي مثل هذه الأيام من شهر يوليو (تموز)، في لقاء اعتادت المشاركة فيه مجموعة من السياسيين والمثقفين السوريين المعارضين، وقتها كانت تتكرر وبوتيرة متسارعة علامات انزلاق ثورة السوريين نحو وجه إسلاموي، أوضحها إطلاق شعارات وأسماء على بعض النشاطات الشعبية والمسلحة تحمل دلالات ورموزاً دينية، يعززها تخصيص المساجد كمحطات لانطلاق المظاهرات ودور يتنامى لأئمتها ومشايخها في تعبئة الناس وتوجيههم، وأيضاً تعمد السلطة تفعيل الاستفزازات والإهانات الطائفية ومسارعتها لإطلاق سراح المئات من المتشددين الإسلامويين من سجونها، في رهان على تغلغلهم في صفوف الحراك السلمي وتشويه بنيته ومطالبه.
«من الخطر التسامح مع الشعارات الإسلاموية التي بدأت تطغى في ساحات التظاهر والاحتجاج»، هي عبارة أعلنها بعض المتحاورين بشكل صريح، محذرين من تجاوز شعاري الحرية والكرامة اللذين وسما الحراك الشعبي وأجمعت عليهما مختلف أطياف المجتمع السوري، فذلك يفقد الثورة فئات متعاطفة معها ويسوّغ حياد قطاعات مهمة من الأقليات الدينية والقومية، كما يضفي على مستقبل التغيير في سوريا صورة منفرة لن ترضي المجتمع الدولي، بل تبرر له سلبيته وتردده في وقف العنف وردع النظام.
من منكم لا يحتمي بالدين ويجعله ملاذاً في حال تعرضه لظلم ومحنة يصعب احتمالهما؟! ولم علينا أن ندين استقواء متظاهرين مسالمين بمخزون إيمانهم كي يعينهم على الاستمرار والصمود، في مواجهة استفزازات طائفية ومذهبية بغيضة وقمع مروع لا يعرف حدوداً ولا يترك دوراً لمنطق سليم أو عقل يفكر؟ هي أسئلة بادر آخرون لطرحها في محاولة لخلق حالة من التفهم والتأييد لتنامي المسار الإسلاموي في الحراك الشعبي، مستقوين بمشاهد لعشرات الآلاف من حملة الشعارات الدينية وهم يتصدون ببسالة لرصاص الاستبداد ويواجهون الموت والاعتقال من دون أن يتنازلوا عن المجاهرة بالشعب السوري الواحد.
بينما ذهب آخرون بعيداً في دفاعهم عن تنامي الظواهر الإسلاموية، مستعينين بما يعتبرونه حقيقة تقول إنه لا خوف من الإسلام السياسي في سوريا، إما لأنه برأيهم لا يمتلك أي حظ أو فرصة للاستئثار بالسلطة والحقل العام في مجتمع تعددي كالمجتمع السوري، وإما لأنهم يعتقدون بوجود مسحة من الخصوصية للقوى الإسلاموية السورية، وبشكل خاص لجماعة «الإخوان المسلمين»، التي بدأت تتمايز برأيهم، قبل الثورة عن الصورة النمطية للإسلام السياسي، وترسم لنفسها وجهاً وطنياً وديمقراطياً عريضاً، وقد خلصت بعد مراجعة نـقدية طاولت معظم مستويات نهجها السياسي، أهدافاً وآليات عمل ووسائل، إلى الإقرار بأن الشعب هو مصدر السلطات، وبالاحتكام لصناديق الاقتراع وتداول السلطة والاعتراف بمختلف مكونات المجتمع السوري واحترام حقوقها وحرياتها ومساواتها أمام القانون.
لم ينفع مع هؤلاء المستهينين بخطر الإسلام السياسي، القول إن ما تذهب إليه الثورة السورية في تكريس وجه طائفي هو أفضل خدمة تقدم للنظام القائم الذي لم يوفر جهداً لتحويل الحراك الشعبي من أفقه السياسي إلى بُعد مذهبي مدمر، كما لم ينفع عرض محاولات بعض الفعاليات الإسلاموية إضرام النار في وقود المذهبية والطائفة أملاً في إحداث تصدعات في بنية النظام وتشجيع الانشقاقات في الجيش، أو داخل مؤسسات الدولة، وأيضاً لم ينفع سوْق أمثلة وتجارب مريرة رسخت في وعي الناس ووجدانهم، عن سرعة وسهولة تنكر جماعات الإسلام السياسي، وفي مقدمتهم «الإخوان المسلمون»، للشعارات المدنية والديمقراطية التي رفعوها، وإصرارهم الفظ، ما إن وصل بعضهم إلى السلطة، على الاستئثار بالحكم والعمل على أسلمة الدولة والمجتمع، وحتى لم ينفع معهم التذكير بالطابع البنيوي لـ«الإخوان» المسلمين الذين لا يزالون يحملون اسماً ذا مدلول طائفي وتحكمهم روابط تنظيمية استبدادية تستند إلى قسم الطاعة والولاء، وتميزوا تاريخياً بعصبيتهم الآيديولوجية وبأساليبهم الإقصائية، مما يجعلهم عاجزين عن تمثل قيم الحرية والمواطنة وعن التحرر من فكرة الدولة الإسلامية ومن الأساليب الاستئثارية والتسلطية لفرض معتقداتهم وآرائهم على أنها الحقيقة المطلقة.
افترق المتحاورون كل على موقفه، وجاءت الوقائع لتقول كلمة الفصل وتسطر درساً لا ينسى عن الدور التخريبي الذي لعبه الإسلام السياسي في تشويه ثورة السوريين وتمكين أعدائها منها، ليس فقط بوجهه الإرهابي ممثلاً بـ«داعش» و«النصرة» وغيرهما من الجماعات المسلحة، وإنما الأهم بوجهه المعتدل ممثلاً بـ«الإخوان المسلمين» ومن على صورتهم، وهؤلاء الأخيرون لم يمرروا فقط وبخبث الشعارات ذات الطابع الإسلاموي في المراحل الأولى من تطور الحراك الشعبي، بل سارعوا إلى دعم ما سمي الهيئات الشرعية التي فرضت في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وأهملوا واجبهم في تعرية الخطاب الديني المتطرف، وما ظهر من تفريعات متنوعة للجماعات الإسلاموية الإرهابية، بما هو إحجام عن تمييز أنفسهم كحركة سياسية معتدلة، كما يدعون، من واجبها خلق إجماعات وطنية بين السوريين، وتعزيز الثقة بين مختلف مكوناتهم، فكيف الحال حين فاضت أفعالهم بروح الاستئثار ومبدأ المغالبة مع الأطياف الوطنية والثورية لتوسيع سيطرتهم على هيئات المعارضة السورية، إنْ بفرض تثقيل حصتهم التنظيمية فيها أو بزرع أكبر عدد ممكن من كوادرهم في المواقع القيادية لمختلف الهيئات السياسية والإغاثية، ما حكم بالفشل على عمل تلك الهيئات أو مأسستها، وأعاق دورها في بلورة نهج وطني جامع، زاد الأمر سوءاً مفاخرتهم، وعلى حساب انتمائهم ورابطهم الوطني، بقوة ارتباطهم بمن يسمونهم إخوة المنهج، والدفاع الأعمى عنهم ظالمين كانوا أو مظلومين، كـ«إخوان» مصر وليبيا وحركة «حماس» وغيرهم.
صحيح أن السلطة السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية فيما وصلنا إليه من خراب وضحايا واعتقال وتشريد، وصحيح أن المأساة السورية وجهت ضربة قوية للثقة بجماعات الإسلام السياسي والرهان على دورها بالخلاص، لكن الصحيح أيضاً أن هذه الجماعات لا تزال تمتلك من النفوذ والدوافع ما يمكنها من إيقاع أشد الأذى بالسوريين ويزيد أوضاعهم سوءاً على سوء، خاصة أنها تعتاش على مناخ عام حاضن يتميز بتفاقم الصراع المذهبي وبتراجع ملموس للسياسة أمام تقدم العنف العاري والتعبئة الطائفية، وبعجز مزمن لقوى التغيير الوطنية عن كسب ثقة الناس والتقاط زمام المبادرة.
الشرق الأوسط
—————————-
“داعش”: مساعٍ لتفعيل المركز بعد سنوات من تألق الفروع الإقليمية/ محمد حسان
مساعي التنظيم إلى إعادة تفعيل قوته في دول المركز والعودة إلى ربط فروعه الإقليمية بالقيادة المركزية بشكل كلي، تأتي مع جميع الظروف المناسبة لعودته كقوة سنية متمردة.
في نهاية عام 2017 وبشكل دراماتيكي سريع، عاش تنظيم “داعش” حالة انهيار سريع لمشروع “الخلافة”، بعد هجوم متزامن استهدف مناطق سيطرته في سوريا والعراق. هذا الهجوم شاركت فيه الحكومة السورية المدعومة روسياً، والحكومة العراقية المدعومة بغطاء جوي من التحالف الدولي، إلى جانب الشريك الأبرز للولايات المتحدة الأميركية في تلك المعركة، “قوات سوريا الديموقراطية”، التي تولت مهمة القضاء على التنظيم في المناطق السورية الواقعة شرق نهر الفرات.
مرحلة الانهيار السريع لـ”داعش”، أدخلت القوى المعادية للتنظيم في تلك المرحلة بحالة من سوء الفهم، الذي يتمثل في التسرع بإعلان النصر على التنظيم والقضاء عليه وعدم التفريق بين مشروع “داعش” السياسي وهو مشروع الدولة بمسماها الإسلامي “الخلافة”، وحالة “المنظمة” أو التنظيم بوصفه مجموعة قتالية متمردة، تملك قدرات هيكلية وتنظيمية ومصادر تمويل ودعماً وسجلاً حافلاً من التجارب الناجحة، للعودة عبر العمل المنظماتي السري، كما في حالة نشأتها الأولى في العراق وبعد مرحلة القضاء عليها عام 2007 على يد الصحوات.
عدم التقدير الجيد للأطراف المعادية للتنظيم لم يتوقف على عدم التفريق بين مشروع التنظيم السياسي وحالة المنظمة المتمردة فقط، بل وقعت تلك الأطراف في سوء تقدير لقوة التنظيم سواء خلال معركة القضاء عليه أو بعد إعلان هزيمته في سوريا والعراق، فما هي إلا أشهر قليلة حتى عاد التنظيم لتوجيه ضرباته في كلا البلدين، بعد تحوله إلى أسلوب “الولايات الأمنية” وحرب العصابات، وإعلانه بدء مرحلة حرب الاستنزاف كخيار عسكري يتلاءم مع واقع التنظيم الجديد.
عودة التنظيم إلى حالة المنظمة بعد انتهاء مشروعه السياسي كـ “دولة” نتيجة انحيازه عن المدن والأرياف التي كانت خاضعة لسيطرته، دفعته إلى التحول من حالة المركزية الشديدة التي كان ينتهجها قبل عام 2017 إلى حالة من اللامركزية الإدارية والعسكرية، حيث بات عمل المنظمة قائماً على وحدات عسكرية ذات نطاق جغرافي محدد. هذه الوحدات تتمتع بقدرة على العمل بلا الحاجة للعودة إلى القيادة المركزية للتنظيم. دوافع التنظيم من هذا كانت واضحة ولها أهداف أهمها الهدف الأمني، لحماية بقايا قيادته المتوارية عن الأنظار والتي كانت الأطراف المعادية له تبذل جهوداً مضنية للقضاء عليها، والهدف الثاني تسهيل عمل الخلايا وتكثيف العمليات العسكرية للحفاظ على فكرة التنظيم وشعاره في البقاء “باقية”.
التنظيم في هذه المرحلة كشف عن سرعة كبيرة في القدرة على إعادة بناء الهيكلية الخاصة به على أساس حالة المنظمة، وأظهر مرونة شديدة في تحوله إلى اللامركزية، حتى إن مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، لم يدخل التنظيم في حالة تخبط أو فقدان توازن، بل إن ترتيبات تولي أمير محمد سعيد عبد المولى زعامة التنظيم، أكدت تلك القدرات في التحول السريع، إضافة إلى دقة اختيار القائد داخل صفوف المنظمة والذي أثبت أنه لا يقل حنكة عن الزعيم السابق.
عودة “داعش” كمنظمة سرية دفعت القوى المناوئة له للبحث عن آليات لمنع عودته، إذ سارعت إلى استدراك خطأ إعلان هزيمة التنظيم عبر محاولة زيادة الضغط والمتابعة الأمنية والعسكرية لخلاياه في سوريا والعراق، ما دفع التنظيم إلى العمل على تخفيف نشاطه في دائرة مركز التنظيم في سوريا والعراق وبدأ يعتمد على تفعيل فروعه الإقليمية، بهدف تفادي ردات فعل الأطراف المعادية له، ولصرف الأنظار عنه في معقل خلافته السابقة وللسماح لفروعه المنتشرة حول العالم بأخذ المبادرة والعمل، بعدما كانت دائرة المركز تستحوذ على الاهتمام الداخلي في التنظيم وبالنسبة إلى الأطراف المعادية له محلياً وعالمياً.
توجه التنظيم إلى تفعيل الفروع الإقليمية هو استنساخ لتجربة تنظيم “القاعدة” بعد التضييق عليه في أفغانستان، وكانت فروع “داعش” الإقليمية بدأت في تلك المرحلة بالظهور، من فرع سيناء في مصر إلى فروعه في أفغانستان وباكستان والفلبين، لكن فرع التنظيم في أفريقيا الوسطى كان الأبرز بالرغم من كونه أحدث فروع التنظيم من ناحية التأسيس، وبرغم من كونه تشكيلاً جاء من طريق توحد مجموعتين مختلفتين الأولى، من جمهورية موزمبيق والثانية من جمهورية الكونغو، إلا أن هذا الفرع فرض نفسه كأقوى الفروع الإقليمية وتمكن من التغطية على عمل قيادته داخل دول المركز.
بعد تفشي فايروس “كورونا”، تنامت هجمات تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، بسبب استمرار العوامل والظروف الموضوعية التي أدت إلى ولادة التنظيم وصعوده على حالها، وتجذرت تلك العوامل والظروف بعد تفشي الفايروس وتراجع دور التحالف الدولي في محاربة التنظيم، هذه الأسباب مجتمعة جعلت التنظيم يعمل منذ فترة ليست ببعيدة على مشروع مرحلي يعتبر من أولوياته الحالية. مرتكز هذا المشروع إعادة تفعيل المنظمة داخل دول المركز “سوريا، العراق”، تمهيداً لمرحلة لاحقة تعيده كمشروع سياسي “دولة” وليس كمنظمة “متمردة”.
سعي “داعش” من خلال تفعيل عمل المنظمة داخل دول المركز له هدفين رئيسيين، الأول على مستوى القيادة داخل التنظيم ويمكن اعتباره ذو طابع شخصي، يتمثل في رغبة القادة العراقيين في البقاء على رأس هرم التنظيم، وهذه الرغبة باتت مهددة خاصة مع بروز نجم فروع التنظيم الإقليمية في أفريقيا وتحديداً في سيناء وأفريقيا الوسطى، حيث تتخوف قيادة التنظيم من تنامي الدور داخل تلك الفروع والوصول لمرحلة تولي زعامة التنظيم بشكل منفرد عبر تعيين قادة جدد أو الانفصال. أما الهدف الثاني، فهو أن التنظيم يرى أن قدرته التأثيرية أكبر في دول المركز وعمله يعطيه الأهمية والدعاية التي يحتاجها نتيجة التداخلات السياسية في سوريا والعراق، بينما هذا غير ممكن في أفريقيا التي لا تعطي التنظيم زخماً دعائياً إعلامياً عبر عمله هناك، بخاصة أنه فقد قدرته حالياً على توجيه ضربات داخل أوروبا التي كانت تحقق له هذا كله بشكل مضاعف.
دلالات كثيرة ظهرت تشير إلى رغبة التنظيم في إعادة قوته في موطئ خلافته الأول. أبرز تلك الدلالات تغيير نوعية الهجمات في العراق من الشكل التقليدي الكلاسيكي عبر عمليات القصف والاغتيالات والهجمات الصغيرة، إلى استخدام الهجمات الانتحارية كما حدث في بغداد نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وهذا الأسلوب توقف التنظيم عن استخدامه منذ فقدانه السيطرة المكانية بعد انهياره عام 2017. الدلالة الثانية هي سحب مجموعات من عناصره في البادية السورية إلى العراق، حيث تشير المعلومات إلى أن التنظيم استقدم قرابة 300 عنصر من البادية إلى العراق في الفترة الماضية لزيادة نفوذه وعملياته في العراق، بخاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة العراقية وحالة التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران على الأراضي العراقية.
ومن الدلالات أيضاً على مساعي التنظيم إلى تفعيل دور المركز، ما جاء في الكلمة الصوتية الجديدة التي بثتها مؤسسة “الفرقان” للمتحدث باسم التنظيم أبو حمزة القرشي، والتي حملت توصيات وتوجيهات زعيم التنظيم في زيادة العمل وإعطاء الأولوية في البحث عن سبل لإطلاق سراح مقاتلي التنظيم الموجودين في سجون الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، وتكثيف العمليات العسكرية بشكل أكبر لتطاول جميع الأطراف المعادية للتنظيم، بخاصة العسكرية وشيوخ العشائر المناهضين للتنظيم.
مساعي التنظيم إلى إعادة تفعيل قوته في دول المركز والعودة إلى ربط فروعه الإقليمية بالقيادة المركزية بشكل كلي، تأتي مع جميع الظروف المناسبة لعودته كقوة سنية متمردة.
أبرز الظروف المناسبة لاستعادة “داعش” نشاطه، يتمثل في استمرار حالة تغول السلطات المحلية الطائفية في العراق وسوريا، وحالة الانقسام الطائفي والعرقي المترافقة مع الفوضى الأمنية والتي ما زالت تتجه نحو الأسوأ.
هذا الواقع ينذر بموجة جديدة من العنف قد تشهدها مدن وبلدات كثيرة في سوريا والعراق، وهو مشابه لما شهدته عام 2014 بعد تمدد التنظيم وسيطرته على أجزاء واسعة في البلدين.
درج
——————————
كيف ساهم نظام الأسد بصعود تنظيم الدولة؟.. شهادات جديدة/ عبيدة عامر
كشفت سلسلة استقصائية جديدة ما اعتبرته “شواهد جديدة” على مساهمة النظام الرئيس السوري بشار الأسد في صعود تنظيم الدولة، منذ ظهوره في العراق عام 2003.
ففي سلسلة استقصائية من ثلاثة أجزاء، اكتشف الصحفي الأمريكي المخضرم روي جتمان، والحائز على جائزة “بولتيزر” للصحافة، واحدة من أكبر الجوائز في الصحافة، أدلة جديدة على ارتباط النظام السوري بتنظيم الدولة، على مدى عامين من الاستقصاء.
ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، ادعى النظام السوري أن الإرهابيين هم الذين أطلقوها، واستخدم جهازه الأمني لجعل الواقع يوافق هذه الدعاية، وليظهر كـ”ضحية للإرهاب”، بناء على مقابلات مع منشقين أمنيين عاليي المستوى من النظام السوري.
اكتشافات مثيرة
وتلقي السلسلة، التي بدأ نشرها على موقع “ديلي بيست”، الخميس، الضوء على قرارات أساسية للنظام السوري، مثل إرسال المتطوعين للقتال ضد الاحتلال الأمريكي للعراق، الذي ساعد بتشكيل تنظيم الدولة، وإطلاق سراح أكثر من 1000 عنصر سابق من تنظيم القاعدة، وعدم قتال تنظيم الدولة.
ومن أهم ما تكشفه السلسلة كذلك أن النظام قام بـ”تمثيل” تفجيرات لمنشآت أمنية له في عام 2011، و2012، لإعطاء الانطباع بأن القاعدة لها وجود مسلح في سوريا، قبل أن تكون كذلك، بالإضافة إلى إعطاء أوامر للقوات الأمنية لعدم التدخل عندما عبر مقاتلو القاعدة من العراق إلى سوريا في عام 2012.
كما أظهر الاستقصاء اختراق القوات الأمنية السورية للقيادة العليا للتنظيمات الإرهابية، وإمكانية التأثير عليها في لحظات محددة.
ومما يثير الاستغراب، بحسب التقرير، أن الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية لم تلق بالا للمنشقين الأمنيين عن النظام السوري، رغم دور الأسد بتنظيم “التمرد الإرهابي” ضد القوات الأمريكية في العراق.
منذ عام 2003
وترجع علاقات الأسد مع مسلحي التنظيمات الجهادية إلى دوره المحوري في التمرد العراقي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003.
وتظهر وثائق سنجار التي عثر عليها في عام 2007، وتحمل تفاصيل خاصة عن عناصر تنظيم الدولة، أن أكثر من 600 مقاتل من السعودية وليبيا وبلدان إسلامية أخرى عبروا إلى العراق عن طريق سوريا، ما بين آب/ أغسطس 2006، وآب/ أغسطس 2007، وسط تأكيد من “مركز مكافحة الإرهاب” في أكاديمية ويست بوينت العسكرية، عن سعي النظام لاختراق هذه الشبكات.
وأكدت وثائق مسربة من “ويكيليكس” من وزارة الداخلية الأمريكية، امتلاك الولايات المتحدة لمعلومات استخباراتية تؤكد دخول كل المقاتلين الأجانب مع تنظيم القاعدة إلى العراق عبر سوريا، ومعرفة نظام الأسد كل مساعديه.
وفي عام 2010، اعترفوا بذلك لمسؤولين أمريكيين كانوا يزورون سوريا، بحسب “ويكيليكس”، حيث قال العميد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري: “نحن، في النظام السوري، لا نقتل أو نهاجم عناصر القاعدة مباشرة، ولكننا نستدخل أنفسنا بهم، ونتحرك في اللحظة المناسبة”، عارضا المساعدة باعتقال الإرهابيين مقابل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.
نصف الحكاية
إلا أن هذا يظهر نصف الحكاية فقط، بحسب تعبير جتمان، بينما نقل مسؤولون استخباراتيون سوريون منشقون، ومقاتلون سابقون في تنظيم القاعدة، عن تشجيع النظام السوري للتطوع ضمن صفوف “الجهاد” ضد أمريكا، وهو ما فعله الآلاف.
وقال أنس الرجب، المقاتل السوري السابق في العراق والذي اعتقل عند عودته إلى سوريا لفترات متفاوتة في سجون المخابرات السورية، إن “سوريا أرادت أن تطيل حرب العراق والهجمات على القوات الأمريكية، لكي لا يتمكن الأمريكيون من القدوم إلى سوريا”.
ولادة الوحش
بدوره، قال محمود الناصر، المسؤول الاستخباراتي المنشق، إن المخابرات تقدر أن 20 ألف عنصر عبروا إلى العراق عندما بدأت الولايات المتحدة هجماتها في آذار/ مارس 2003، لكن معظمهم عاد مباشرة بعد سقوط بغداد بثلاثة أسابيع.
وقال الناصر، رئيس المخابرات السياسية في مدينة رأس العين شمال سوريا، إن “5 آلاف آخرين عبروا لأسباب أيديولوجية، وهم الذين تسببوا بولادة الوحش”، تنظيم الدولة، الذي يسيطر على مساحات كبيرة في سوريا والعراق، مؤكدا “فتح كل الأبواب للجهاديين ليذهبوا إلى العراق”.
ويعمل الناصر الآن مع “محامي سوريا الأحرار”، جنوب تركيا، بجمع بيانات حول جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري، بحسب “الديلي بيست”.
بدوره، أكد مسعود برزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، في مقابلة لـ”الديلي بيست” في قاعدة السهيل العسكرية، أن “الحكومة السورية ارتكبت خطأ كبيرا في عام 2003″، مشيرا إلى أنهم “فتحوا الباب للإرهابيين ليضغطوا على القوات الأمريكية في العراق، بحيث لا يفكرون بالحب ضد سوريا”.
وحمل برزاني النظام السوري “مسؤولية كبيرة” عما جرى في العراق، معتبرا أن نتائج ذلك هي “ولادة القاعدة في العراق ثم داعش ثم المتطرفين الذين انتشروا في سوريا”.
أبو القعقاع
ومر كثير من المتطوعين للقتال في سوريا بتدريب وتوجيه، تحت إشراف المخابرات السورية، قبل مغادرتهم إلى العراق، وكان أبرز شخصيات الحشد والتوجيه هو محمود الأغاسي، المعروف باسم أبي القعقاع، الذي كان يحشد من مسجد “التوابين” في حلب.
وقال بسام بارباندي، الدبلوماسي السوري السابق الذي يعيش الآن في واشنطن، إن أبا القعقاع “كان ينظم مظاهرات من مسجده إلى منتصف المدينة، بهتافات: سنذبح الأمريكيين، كما كان يضمن أن المقاتلين الأجانب لن يكون لديهم مشاكل إذا جاؤوا”.
وأكد بارباندي أن أبا القعقاع كان تحت “رعاية من كبار المسؤولين”، مشيرا إلى أنه “من المستحيل أن يعمل في دولة بوليسية مثل سوريا بدون موافقة عالية المستوى”.
وجندت المخابرات السورية أئمة، كعملاء لها أثناء دراستهم للشريعة في الكليات، حيث قال الناصر إننا “عينا بعض هؤلاء الأئمة كمخابرات سورية، وكان أبو القعقاع واحدا من عدة”.
قوافل بشار الأسد
ويروي رائد علاوي، أحد المجندين السوريين من مدينة حماة السورية، والذين ذهبوا ليحضروا لأبي القعقاع، أن بعض المدربين كانوا من مخابرات الأسد، وبعضهم رافق هؤلاء المجندين إلى الحدود العراقية بما أسماه المجندون: “قوافل بشار الأسد”.
وقال الضابط السابق في شرطة الأسد عواد العلي إن الحكومة الأمريكية كانت على اطلاع طيلة هذه العملية، حيث كان أبو القعقاع، الذي تم اغتياله في عام 2007 ربما على يد المخابرات الأمريكية، قدم للمخابرات قوائم بأسماء المتدربين.
وأكد الناصر أن المخابرات السورية “بقيت على اطلاع” بمن غادر، استعدادا لعودتهم، حيث كان قسم المخابرات الدينية في إدارة المخابرات العامة، أحد هذه الأجهزة التي تتجسس.
ولم يرجع ربع الذين ذهبوا، إما بانضمامهم للقاعدة، أو موتهم في معارك، بحسب الناصر، بينما اعتقل 1500 من الذين عادوا بتهم مرتبطة بالإرهاب.
صيدنايا
ويعتبر سجن “صيدنايا” أسوأ هذه السجون السياسية سمعة في سوريا، حيث يروي دياب سرية، الناشط المدني الذي قضى خمس سنوات في صيدنايا، وأطلق سراحه في 2011، أن عدد “الأصوليين الإسلاميين” الذين اعتقلوا معه ارتفع من 300 عندما وصل في عام 2006، إلى 900 عندما أطلق سراحه، وكانوا جميعا محكومين ما بين خمسة إلى 15 عاما، بتهم مرتبطة بالإرهاب.
ويرى جتمان في استقصائه أن “صيدنايا لم يكن مركزا للتأهيل، ولكن حاضنة للجهادية، بحسب مسؤولين سابقين ومنشقين عن الاستخبارات”، بينما اعتبره بعض المعتقلين السابقين سجن خمس نجوم.
وبحسب مسؤولين استخباراتيين وسجناء سابقين، فإن المعتقلين كانوا يصنفون بحسب الأيديولوجيا، حيث كان هناك مهجعان محجوزان لأشد الإسلاميين تطرفا، والذين أصبح عدد منهم لاحقا في مواقع قيادية في تنظيم الدولة، واثنان للأقل تطرفا، بينهم الآن العديد في جبهة فتح الشام، وثلاثة للإسلاميين الأكثر اعتدالا، بينهم الآن قيادات بارزة في حركة أحرار الشام الإسلامية.
وبقي هناك ثلاثة مهاجع لإسلاميين معتدلين و”ديمقراطيين” مثل سرية، الذي قال إن الأصوليين الإسلاميين تنظموا مثل “الخلافة”، حيث كانت المجموعات تؤدي لهم البيعة كأمراء، كما هو حال التنظيمات في الخارج
وكانوا يكتبون شعارات على الجدران، ويضعون أهدافا عند خروجهم، بحسب سرية، الذي أكد “أن بعضهم كان موهوما بأنه حال خروجه سيتوجه إلى دمشق ويؤسس الخلافة هناك”.
وعندما بدأت الثورة في منتصف آذار/ مارس 2011، بدأ الأسد بإطلاق سراح هؤلاء تباعا من صيدنايا، قائلا إن هذا كان استجابة لمطالب الناشطين بإطلاق سراح السجناء السياسيين، بينما وصف الناصر ما جرى من “إرسال متطرفي القاعدة من بلد يعاني الفوضى كان مخططا ساخرا لاستخدام المتطرفين لتحقيق أهداف سياسية”.
وأوضح: “السبب الذي أطلق الأسد لأجله سراح هؤلاء مع بداية الثورة كان إتمام عسكرة الثورة، ولتحفيز النشاطات الجنائية بحيث تصبح الثورة قضية جنائية، لإعطاء الانطباع أن النظام يقاتل الإرهابيين”.
اختراق وإدارة
وشكلت المخابرات السورية علاقات داخل السجن مع المتطرفين، سامحة لهم بتعقب صعودهم داخل الحراك الثورية، بحسب سرية والعلي ومسؤولين استخباراتيين سابقين، إذ أكد سرية أن “كل تنظيم متطرف مخترق من النظام”.
ولم يقف الحد عند اختراق الشبكات، بل أدارها كذلك عبر “تصميم هياكلها”، حيث قال علي مملوك لمسؤولين أمريكيين في عام 2010، إن النظام إجرائيا “سيستدخل نفسه” ضمن المتطرفين الإسلاميين لإدارتهم لاحقا.
ويروي نبيل دندل، المدير السابق للمخابرات السياسية في اللاذقية، أنه قاد عمليات أمنية ضد خلايا للقاعدة، ليعرف لاحقا أن مدير هذه الخلية تابع ومدعوم من المخابرات السورية.
وأكد دندل أن النظام السوري “كان يعدهم ليصبحوا زعماء”، مستشهدا بحالة نديم بلوش، زعيم خلية للقاعدة، اعتقل في عام 2006، وقال له: “لا تفعل شيئا، أنا أعمل لصالح آصف شوكت”، صهر الأسد الذي عمل نائبا لوزير الدفاع السوري، والذي اعتقل في تركيا قبل عام، وقيل إنه انتحر في السجن.
وقدر قاض سابق للنظام، انضم للثورة، أن نصف القياديين في تنظيم الدولة يعملون مع النظام، بينما قال منشق آخر إن الثلث يعمل كذلك، أما الناصر فرأى أن كبار القياديين في تنظيم الدولة مرتبطون بالمخابرات السورية.
ويروي الناشط المدني عبد الله الحكواتي أن “المتطرفين في سجن حلب المركزي لهم علاقة ممتازة جدا مع الحراس، بعكس السجناء المدنيين الذين لا يملكون أي امتيازات”.
وكان هناك ستة سجناء من صيدنايا، وآخرون من سجن تدمر الكبير، وفرع فلسطين، والفرع “291”، ليصل عددهم إلى 15 سجينا من القاعدة، مع 15 سجينا مدنيا مثل حكواتي.
وكان لسجناء القاعدة امتيازات، بحسب ما يستذكر الحكواتي، منها إمكانية امتلاكهم للهواتف، والوصول للإنترنت، وإطلاق لحيتهم، ولباسهم الأفغاني، وطلب وجبات من الخارج، وكان لديهم دروس دينية، يدعون بها بسلامة زعماء القاعدة، حيث يذكر أنه “سمع خطبة كاملة لبن لادن” في السجن.
“مديرو السجن”
وإذا كان هناك اعتداء من السلطات على أحد الناشطين المدنيين، فقد كانت عناصر القاعدة يتدخلون لحمايته، حيث وصفهم حكواتي بأنهم “مديرو السجن، الذي كان نعيما لهم”، وبعد أسابيع من هذه الحالة، انضم خمسة من زملائه إليهم.
ويستذكر الحكواتي الفرق بين الحالتين، حيث قال أحدهم واسمه محمود مانيجاني لعميد السجن: “عندما أخرج سأقتلك”، فقال له: “هذا شيء تقرره فقط”، بينما عندما كان هناك اعتراض من الناشطين المدنيين على أن الطعام غير كافٍ، كانوا يهددونه: “هل تريدني أن ألعب بخصيتيك؟”.
وكان للعلاقة بين الناشطين والمتطرفين أن تكون عدائية، حيث يذكر أنه بعد نقاش فلسفي جرى بين مانيجاني وبينه حول معنى “الإله”، ضربه الإسلامي، بينما، في موقف آخر، شكره عنصر آخر قائلا له: “بفضل مظاهراتكم فقط نحن مرتاحون اليوم”.
مواقع قيادية
وتصدر سجناء صيدنايا السابقون مواقع قيادية في الفصائل والكتائب التي وصفت بالإسلامية.
فمن بينهم، كان أبو لقمان، أحد مؤسسي جبهة النصرة في سوريا، والذي يعمل الآن كأمير الرقة في تنظيم الدولة، والمسؤول الأمني في التنظيم محمود الخليف، ومسؤول العلاقات حاج فاضل الآغال، بحسب التقرير.
وكان أبو عبد الرحمن الحموي، أمير النصرة في حماة، وأبو ناصر دروشة، ابن عم أبو محمد الجولاني، زعيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، وأبو حسين زينية، مسؤول النصرة في القلمون، وأبو حفص الكسواني، مسؤول التنظيم في درعا.
وكان من بين خريجي صيدنايا، أبو جابر الشيخ، الذي ترأس الجبهة الإسلامية السورية، التي ضمت الفصائل الإسلامية البعيدة عن القاعدة، ومن بينها جيش الإسلام، الذي ترأسه زهران علوش، قبل أن يقتل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والذي كان في صيدنايا كذلك، بجانب أحمد عيسى الشيخ، أمير “صقور الشام”، وحسان عبود، مؤسس “أحرار الشام”، الذي قتل مع كبار قادة التنظيم في تفجير غامض في أيلول/ سبتمبر 2014.
ورأى العلي أن وجود هذه القيادات في صيدنايا كان مثل “التخرج بشهادة الشرف”، موضحا بقوله إن الناس سيقولون إن “هذا الشخص دفع ثمنا غاليا في صيدنايا”، ثم يصفونه بالشيخ.
الرابح الأكبر
ورأى جتمان، في ختام الجزء الأول من تحقيقه، أن المستفيد الأكبر هي المخابرات السورية، التي كانت على معرفة كافية بالسجناء السابقين، وحفظها ملفا لكل واحد منهم.
ورأى الناشطون المدنيون أن هذا كان من خطة النظام لإفساد الثورة.
ورأى دياب سرية أن النظام نجح في ذلك: “فقد كان ناجحا جدا في تشويه الثورة، ليظهر المعركة كأنها بين النظام العلماني والتنظيمات الإسلامية المتطرفة”.
عربي21- عبيدة عامر
—————————————-
=========================